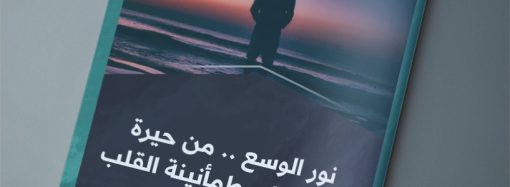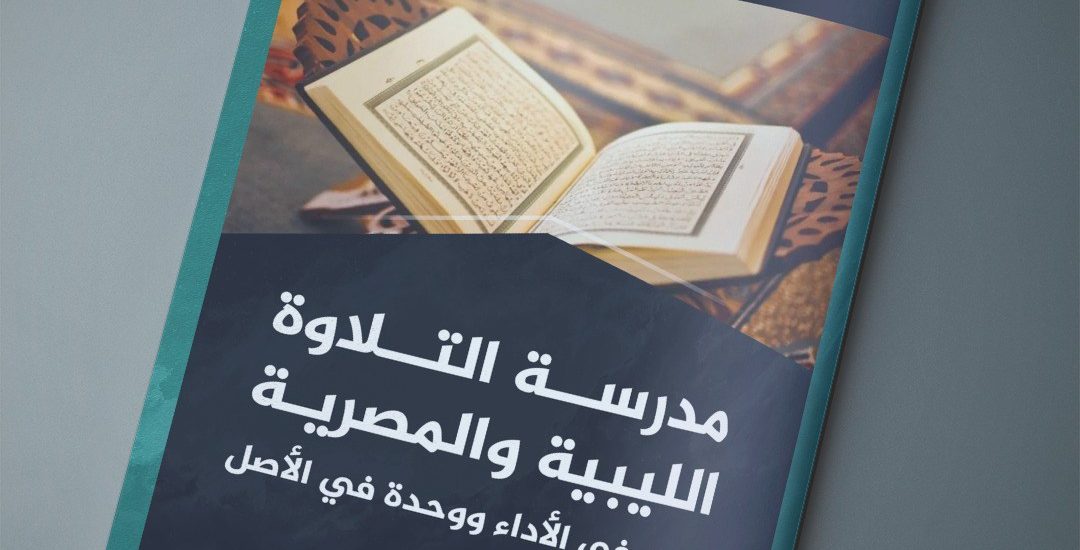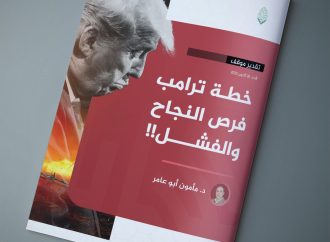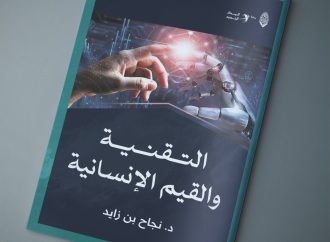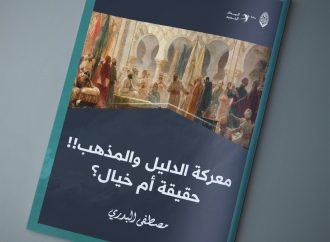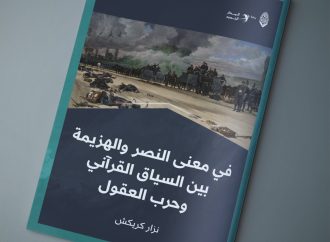مقال بعنوان: مدرسة التلاوة الليبية والمصرية .. تنوع في الأداء ووحدة في الأصل، بقلم الأستاذ: محمد عمران.
مدرسة التلاوة الليبية والمصرية .. تنوع في الأداء ووحدة في الأصل
تلاوة القرآن الكريم ليست مجرد قراءة نص يتعبد بتلاوته فقط، بل هي فن وعلم يتوارث عبر الأجيال، يحمل في طياته أبعادًا روحية وجمالية عميقة..
في عالم التلاوة تبرز مدارس متعددة تحمل كل منها بصمة بلدها وروح ثقافته، مع التزامها بما تواتر من أداء وقرر من أحكام، ومن أبرز هذه المدارس: المدرسة المصرية ذات الانتشار العالمي، والمدرسة الليبية ذات الطابع المميّز، ولسنا هنا بصدد المقارنة لتفضيل إحداهما على الأخرى – فهما كفرسي رهان – بل لاستكشاف ثراء التنوع الأدائي والفني الذي يظل وحدا في الأصل والمنبع، متعددا في الذوق والجمال.
لقد أولت الأمة الإسلامية عبر تاريخها اهتمامًا بالغًا بكتاب الله تعالى، حفظًا وتجويدًا وأداءً ورسما وضبطا وعدّا وقراءة وتفسيرا .. إلى غير ذلك من العلوم المتعلقة بالقرآن؛ وقد نتج عن الاهتمام بالأداء – وأعني بذلك الأداء الفني المتعلق بالصوت والتغني – نشوء مدارس متنوعة للتلاوة في مختلف بقاع العالم الإسلامي، كمدرسة مصر والحجاز وليبيا والمغرب والسودان وغيرها، هذه المدارس وإن اتفقت في جوهرها على إتقان أحكام التجويد والحرص على الأداء السليم – على تفاوت في ذلك طبعا – إلا أنها تباينت في سماتها وخصائصها النغمية والفنية – المندرجة تحت إطار التغني المطلوب شرعا – متأثرة بالبيئة الثقافية والتاريخية والإقليمية، وهذا بلا شك سنة من سنن التنوع التي فطر الله العباد عليها ..
في هذا المقال ارتئينا تسليط الضوء على اثنتين من أبرز هذه المدارس: مدرسة التلاوة الليبية، ومدرسة التلاوة المصرية، مع بيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما، وتحليل الخصائص التي ميزت كلا منهما على الأخرى؛ وذلك لتقديم فهمٍ أعمق للتنوع الثريّ في فن تلاوة القرآن الكريم، وبالله التوفيق..
مدرسة التلاوة الليبية .. أصالة وعمق
تتميز مدرسة التلاوة الليبية بجذور تاريخية عميقة؛ إذ كان التعليم القرآنيّ جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والثقافي الليبيّ، فبعد الفتح الإسلامي مباشرة كانت القراءة السائدة في ليبيا هي قراءة الإمام ابن عامر اليحصبيّ، شيخ قراء الشام، بروايتيها: هشام السلميّ، وعبد الله بن ذكوان، وبعد انتشار المذهب المالكيّ على يد علماء كثر كعليّ بن زياد العبسيّ، وأسد بن الفرات السلميّ، تبنّت ليبيا قراءة الإمام نافع المدنيّ بروايتيها: قالون وورش؛ وذلك لارتباط المذهب المالكيّ بقراءة نافع المدنيّ لكونه من المدينة، وبالأخص أصبحت رواية الإمام قالون عن نافع هي الرواية الشائعة والرسمية في معظم مدن ليبيا، مع التزام بعض المدن برواية ورش كمدينة الجغبوب اتباعا لما كان يقرأ به الولي الصالح الإمام الشيخ محمد علي السنوسي رحمه الله، وحديثا بدأت رواية حفص عن عاصم تأخذ رواجا عند الكثير من الحفاظ الليبيين، تأثرا بانتشارها الواسع على الصعيد العالمي.
لقد لعبت المؤسسات التعليمية التقليدية دورًا محوريًا في صقل هذه المدرسة؛ فقد كانت الزوايا والكتاتيب والمدارس القرآنية ومعاهد القراءات والمنارات مراكز إشعاع لتعليم القرآن الكريم وعلومه، هذه المؤسسات لم تقتصر على تحفيظ القرآن فحسب، بل اهتمت أيضًا بتعليم أحكام التجويد، وفن الأداء، والقراءات المختلفة؛ مما أسهم في تخريج أجيال من القراء الضابضين المتقنين، وأصحاب الأصوات العذبة الندية.
الخصائص والسمات المميزة لمدرسة التلاوة الليبية
تتسم المدرسة الليبية في تلاوة القرآن الكريم بعدة سمات فريدة – منحتها طابعًا خاصا – يمكن إجمالها في أمرين:
أولا: السمات التربوية والمنهجية:
تركز المدرسة الليبية على السمات التربوية العميقة في تعليم القرآن، وبناء العلاقة الروحية بين التلميذ والشيخ؛ فهي لا تنظر إلى التلاوة كمجرد أداء صوتي فقط، بل كعبادة ومسؤولية كبيرة تحفز الطالب على التخلق بأخلاق القرآن والتأدب بآدابه؛ مما يربي الطالب على تعظيم القرآن الكريم وتبجيله، كما أن المناهج التعليمية القرآنية في ليبيا تركز كثيرا على الجودة والإتقان في كل ما يدرسه الطالب من أحكام ورسم وضبط ووقف وابتداء، مع الاعتناء بالمتشابهات التي تعرف عندهم بالتنزيلات والتفنن في ضبضها، واعتماد الألواح في الكتابة والحفظ مما يعين على قوة الاستحضار وتثبيت المحفوظ، كل هذا وغيره كان سببا في الكثرة الكارثة من الحفّاظ والمتقنين؛ حتى سميت ليبيا فيما بعد “بلد المليون حافظ” وحفاظها في الواقع أزيد من ذلك بكثير.
ثانيا: خصوصيات الأداء الفني:
تتميز المدرسة الليبية بخصوصيات في التعليم القرآني تشمل الرسم والضبط، والوقف والابتداء، والتجويد والأداء، والقراءة والرواية والطريق .. وعلى صعيد الأداء امتاز القراء الليبيون بكونهم يقرؤون بأصواتهم الأصيلة – حسبما يتفق لهم – دون تقليد لأصوات الآخرين إلا على سبيل التبع لا الأصالة؛ مما يجعل صوت القارئ الليبي هو المسيطر في التلاوة، وهذه ميزة بارزة تعكس الأصالة والعفوية في الأداء، وهذا التركيز على الصوت الشخصي والأداء الطبيعي يمنح التلاوة الليبية نكهة خاصة تعبر عن روح القارئ وتدبره للآيات، كما تميز القراء الليبيون بقوة الأحكام وسلامة المخارج التي ميزتهم بشكل خاص عن بقيت المدارس؛ لقرب لسانهم من العربية.. وفوزهم بالتراتيب الأولى في معظم المسابقات الدولية خير شاهد على ذلك، بالإضافة إلى تنوع المقامات الصوتية التي تخرج منهم اتفاقا من غير قصد ولا تكلف؛ لأن الغالب فيهم عدم الدراية النغمية التي تدرس بشكل أكاديمي تحت إطار علم مقامات الموسيقى الشرقية، كما هو الحال في المدرسة المصرية التي كانت لها معاهد خاصة تعنى بدراسة الموسيقى والمقامات الصوتية وقواعد النغم، ومن أهم المقامات التي برع القراء الليبيون في استعمالها مقام البيات؛ فقد أكثروا منه جدا حتى صار يسمى في عرف القراء وخبراء الأصوات بالبيات الليبي؛ لما أضفوا عليه من إحساس وذوق خاص تميزوا به، ومعلوم أن مقام البيات يعرف بنغماته التي تجمع بين الشجن والرقة والفرح وعمق الإحساس، وهو مقام يتميز بكونه هادئًا مناسبا لمنطقة الوسط والقرار، وله استخدامات واسعة في تلاوة القرآن الكريم، وقد جعله المجودون مفتاحا للبدء وقفلا للختام مع التعريج عليه في وسط التلاوة، كما اشتهر ذلك عند القراء المصريين على وجه الخصوص.
أشهر القراء:
أنجبت ليبيا العديد من القراء البارزين الذين أثروا الساحة القرآنية بأصواتهم العذبة وأدائهم المتقن، ومن هؤلاء القراء مثلاً: الشيخ محمد عبد السلام أبو سنينة، والشيخ الدوكالي محمد العالم، والشيخ مفتاح السلطني، والشيخ الأمين قنيوة، والشيخ أحمد القريو، والشيخ محمد خليل الزروق، والشيخ داوود حمزة، والشيخ وليد النائحي وغيرهم الكثير ممن حملوا لواء التلاوة الليبية وأوصلوها إلى العالمية، وكانت لهم تسجيلات وختمات في الإذاعة الليبية، كما كان لهم تميز واضح بالدقة في الأداء وحسن الصوت، واستعمال المقامات المتنوعة، وإن غلب على بعضهم التركيز على بعض منها في الجملة، كتركيز أبو سنينة على الصبا، والدوكالي على الراست، والنائحي على البيات، مع إتيانهم في بعض الأحيان بمقامات أخرى سواء الأصلية أم الفرعية، ولكنها تخرج منهم بشكل عفوي دون قصد أو تكلُّف في الغالب؛ لحرصهم على تغليب الأحكام على قواعد النغم، مع العلم بأن كل قارئ من هؤلاء يصلح أن يكون مدرسة بحاله بالنظر الجزئي إلى غيره فلو أخذنا مثلا القارئ الشيخ محمد خليل الزروق – حفظه الله – لوجدنا أنه مدرسة متكاملة الأركان في الصوت والأداء تستحق الإفراد بالبحث والدراسة، إضافة إلى علمه الواسع باللغة وعلوم القرآن، إلا أننا هنا إنما ننظر في القدر المشترك فيما بين هؤلاء القراء الذي يشكل معالم المدرسة الليبية بشكل عام، خاصة وأننا بإزاء المقارنة مع المدرسة المصرية، التي تحوي بدورها مدارس كثيرة بالنظر الجزئيّ إلى كل قارئ فيها، ولكن حسبنا في هذا المقام مقابلة العام بالعام، أما النظر إلى خصوص كل قارئ على حدة فليس ذلك مما نحن بصدده، ولا يتسع بسطه في مثل هذا الموضع.
تُظهر هذه الخصائص أن مدرسة التلاوة الليبية ليست مجرد طريقة في الأداء، بل هي منظومة متكاملة تجمع بين الأصالة التاريخية، والمنهجية التربوية، والخصوصية الفنية، مما يجعلها ركيزة أساسية في خدمة كتاب الله.
المدرسة الليبية: صرامة البداوة ووقار الخشوع
تنبع خصوصية المدرسة الليبية من ارتباطها بالبيئة الصحراوية والثقافة البدوية الأصيلة، التي تتميز بالصرامة والجدية والابتعاد عن التكلف، مما ينعكس على أدائها في التلاوة، فيقرأ القرآن بخشوع ووقار يلامس القلب.
الجدية وإخلاص النطق:
تقدم التلاوة الليبية نموذجًا متميزًا يركز على إخراج الحروف من مخارجها بدقة متناهية، وهذا الأداء يعطي إحساسًا بالوقار والعمق، وكأن القارئ يخاطب المستمع بحكمة وروية، بعيدًا عن الإثارة العاطفية المباشرة.
النغمة المميزة ووضوح الحروف:
يتميز الصوت الليبي عادةً بالحدة والوضوح الشديد، مع نبرة جادة تنسجم مع الطابع العام، كما يظهر نطقًا قويًا وواضحًا للحروف المفخمة مثلا (كالطاء والضاد والقاف)؛ مما يعزز الإحساس بالأصالة اللغوية، والصوتية.
سبب غياب نمط التجويد في مدرسة التلاوة الليبية:
غياب “فن التجويد” بالصورة المصرية في ليبيا لا يعد نقصًا، بل هو اختيار واعٍ لأسلوب مختلف في الأداء له جذوره التاريخية والثقافية الخاصة.
ويمكن تلخيص الأسباب في النقاط التالية:
أولا: الالتزام بالرواية كقراءة وليس كأداء نغمي، فالمدرسة الليبية، ومعها مدارس المغرب العربي عمومًا، تركز بشكل أساسي على الدقة في تطبيق أحكام رواية قالون عن نافع، فالأولوية القصوى للقارئ الليبي هي صحة النطق ومخارج الحروف، والالتزام الصارم بأصول الرواية، أما الجانب النغمي فيأتي في المرتبة الثانية، ويعد وسيلة لتزيين القراءة، وليس غاية في حد ذاته.
هذا الأسلوب يُعرف أحيانًا بـ “التلاوة العلمية” أو “التلاوة التعليمية”، حيث يكون الهدف هو نقل النص القرآني بأقصى درجات الأمانة الصوتية.
ثانيا: التأثر بالبيئة الثقافية والاجتماعية:
المدرسة المصرية نشأت في بيئة فنية غنية، حيث كان فن المقامات الموسيقية والغناء راسخًا، مع وجود الكثير من الملحنين والمطربين والأدباء، فتأثر الكثير من كبار القراء المصريين مثل الشيخ محمد رفعت والشيخ مصطفى إسماعيل بهذا المحيط، فدمجوا المقامات الموسيقية العربية بشكل متقن في تلاواتهم، مما خلق مدرسة فريدة تركز على الجمال الصوتي والتعبير النغمي عن معاني الآيات، زد على ذلك البيئة الإقليمية التي كان يعيشها أغلب القراء المصريين خاصة في الصعيد، فقد كان معظمهم يعيش أجواء الريف والفلاحة، مما أثر ذلك على رقة مشاعرهم ومن ثم التعبير عن هذه الأحاسيس في فن التلاوة.
المدرسة الليبية تطورت في بيئة أكثر تحفظًا من الناحية الموسيقية، حيث كانت الزوايا القرآنية والكتاتيب هي المركز الأساسي لتعليم القرآن، وكان التركيز منصبًا على الحفظ والتلقين الدقيق للنص القرآني؛ لذلك فإن الأداء الصوتي للقارئ الليبي غالبًا ما يكون أكثر هدوءًا وبساطة، ويبتعد عن التطريب والاستعراض الصوتي الذي قد يُنظر إليه على أنه مبالغة قد تخل بوقار النص القرآني.
ثالثا: طبيعة رواية قالون نفسها:
رواية قالون عن نافع بخصائصها الصوتية كقصر المد المنفصل وصلة ميم الجمع، تفرض إيقاعًا سريعًا نسبيًا على التلاوة (خصوصًا في مرتبة الحدر والتدوير)، هذا الإيقاع قد لا يتناسب دائمًا مع التطريب والتطويل الصوتي الذي تتطلبه المقامات الموسيقية المعقدة، والذي يظهر بشكل أوضح في رواية حفص التي يقرأ بها معظم قراء المدرسة المصرية.
رابعا: مفهوم “الخشوع”:
يرتبط الخشوع غالبًا بالبساطة والهدوء في التلاوة، ويُعتقد أن الإفراط في الزخرفة النغمية قد يشتت انتباه المستمع عن تدبر المعاني، ويركز اهتمامه على جمال صوت القارئ، بينما في المدرسة المصرية يُعتبر الأداء النغمي المؤثر وسيلة قوية لإيصال المعنى وإثارة مشاعر الخشوع لدى السامع.
وعلى كل حال فلا يمكن القول بأن فن التجويد غائب عن الساحة الليبية، بل هو موجود بأسلوب مختلف، فبدلاً من فن الأداء النغمي المصري، تتميز ليبيا بفن “الأداء العلمي الدقيق”، الذي يجد جماله في بساطته وقربه من النص الأصلي، وهو أسلوب له وقاره وجمهوره ومحبوه الذين يجدون فيه السكينة والخشوع.
المدرسة المصرية: فسيفساء الألحان والتأثير العاطفي
تشكلت المدرسة المصرية لتصبح العملاق الأكثر تأثيرًا في العالم الإسلامي، مدعومة بتاريخ طويل من الإذاعات والتسجيلات المتنوعة، والمقارئ المرئية في الحفلات والمناسبات، التي جعلت صوت قارئها جزءًا من الذاكرة السمعية لملايين الناس في مختلف بقاع الأرض، مسلمين وغير مسلمين.
فن التطريب والإنشاد:
تمتاز مدرسة التلاوة المصرية بالاهتمام البالغ بالجانب الموسيقي، أو ما يعرف بـ “فن التطريب”، فقد أتقن قراؤها فن صياغة الألحان التي تتناغم مع معنى الآيات، مستخدمين المقامات الموسيقية الأساسية (النهاوند والبيات والراست والحجاز والسيكاه والصبا والعجم والكرد) المجموعة في قولهم “صنع بسحرك” ببراعة فائقة، مع استعمال المقامات المتفرعة منها، وهذا الأداء لا يقتصر على تجويد الكلمات فحسب، بل يهدف إلى نقل المستمع لرحلة عاطفية تتراوح بين الفرح والرهبة والرجاء، مما يزيد من خشوعه وتأثره.
الطاقة الصوتية:
يتمتع قراء مصر بأصوات جهورية قادرة على ملء المساحات الصوتية الشاسعة، مع قدرة مذهلة على التنويع بين نبرات القوة والجزالة في آيات العذاب، ونبرات الرقة والترنم في آيات الرحمة، كما اشتهر بعضهم باستخدام “التحبير” – وهو إدخال كلمات مناجاة مثل “يا الله” بين الآيات – كأداة لتوكيد المعنى وشد انتباه المستمع، وإن كان هذا الأمر محل اجتهاد بين العلماء.
مدرسة التلاوة المصرية .. ريادة وتأثير عالمي
تُعد مدرسة التلاوة المصرية من أبرز وأشهر مدارس التلاوة في العالم الإسلامي، وقد اكتسبت هذه المكانة بفضل أصواتها الشجية وأدائها المتقن الذي أثر في أجيال من القراء والمستمعين، تاريخيًا كانت القراءة السائدة في مصر منذ القرن الثالث الهجري وحتى أواخر القرن الخامس هي قراءة أهل المدينة، خاصة برواية ورش عن نافع المدني، لكن مع مرور الوقت حلت محلها رواية حفص عن عاصم، التي أصبحت الرواية الأكثر انتشارًا في مصر والعالم الإسلامي بأسره، تليها راوية قالون وورش والدوري عن أبي عمر.
الخصائص والسمات المميزة للمدرسة المصرية:
تتسم المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم بعدة خصائص جعلتها تحظى بتلك المكانة الكبيرة.
أولا: دقة أحكام التجويد:
يولي القراء المصريون اهتمامًا بالغًا لأحكام التجويد، مما يضمن الأداء الصحيح للحروف والكلمات وفقًا لقواعد علم التجويد، وإن لم يكونوا في ذلك على وزان واحد في الجملة، كما هو الحال في المدرسة الليبية؛ نظرا للمبالغة النغمية عند كثير منهم، إضافة إلى تأثير لهجتهم الدارجة على بعض المخارج، كما يظهر هذا جليا في مخرج الطاء الذي ينطقونه قريبا من التاء نوعا ما.
التغني بالمقامات العربية:
تتميز التلاوة المصرية بالتغني بالقرآن الكريم وفقًا لمقامات النغم العربية، حيث يمتلك القارئ المصري القدرة على التنقل بسلاسة بين المقامات الموسيقية المختلفة لإضفاء جمال ورونق على التلاوة، وقد وُضعت قواعد شبه راسخة للتعامل مع هذه المقامات وترتيبها في التلاوة منذ تأسيس الإذاعة المصرية عام 1937م، بإشراف ثلة من أكابر القراء.
الاستهلال المنظم والانتقال بين المقامات:
أصبح الاستهلال بمقام البياتي قاعدة لا تتغير في التلاوة المصرية، ثم ينتقل القارئ منه إلى مقامات أخرى مثل الراست و الحجاز، ثم النهاوند، ثم الصبا، أو السيكاه، ثم العجم أو الجهاركاه، ثم العودة إلى البياتي تمهيدًا للختام.
هذا الترتيب المنظم يمنح التلاوة المصرية بناءً متماسكًا وجمالًا خاصًا.
إجادة العديد من القراءات:
يتميز القراء المصريون بإجادة العديد من القراءات القرآنية بأحكامها، مما يثري التلاوة ويبرز عمق المعرفة القرآنية لديهم.
قواعد صارمة للاعتراف بالقراء:
كانت الإذاعة المصرية تلعب دورًا محوريًا في تحديد معايير القبول للقراء، حيث كانت هناك لجان صارمة مكونة من قسمين: أحدهما متعلق بأحكام التلاوة والتجويد والحفظ، والآخر يتعلق بحلاوة الصوت والقدرة على الانتقال بين المقامات المعتادة، هذه القواعد الصارمة ضمنت جودة الأداء من جهة، ورفعت من مكانة القارئ المصري من جهة أخرى..
أعلام المدرسة المصرية
أنجبت مصر كوكبة من القراء العظام الذين أثروا العالم الإسلامي بتلاواتهم الخالدة، ومن أبرزهم: الشيخ علي محمود الذي جمع بين فن التلاوة والإنشاد، والشيخ محمد رفعت الملقب بقيثارة السماء، والشيخ محمد الصيفي الملقب بأبو القراء والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي الملقب بفيلسوف القراء، والشيخ طه الفشني حامل لواء فن الإنشاد، والشيخ مصطفى إسماعيل سيد النغم والتنقلات البديعة، والشيخ محمود عبد الحكم صاحب الصوت الوقور، والشيخ محمود خليل الحصري ميزان القرٱن الدقيق، والشيخ محمد صديق المنشاوي القارئ الباكي صاحب الصوت الرقيق والخاشع، والشيخ سيد نقشبندي أيقونة الإنشاد والابتهالات الدينية، والشيخ كامل يوسف البهتيمي الملقب بالحنجرة الفولاذية، والشيخ أبو العينين شعيشع كروان القراءة ونقيب القراء، والشيخ محمود علي البنا صوت الملائكة، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد صاحب الحنجرة الذهبية الملقب بصوت السماء، والشيخ محمد الطبلاوي خاتمة القراء، والشيخ راغب مصطفى غلوش صاحب الروعة والجمال، والشيخ محمد عمران، والشيخ أحمد نعينع، والشيخ ياسر الشرقاوي، وغيرهم الكثير ممن تركوا بصمة لا تُمحى في فن التلاوة، خاصة في مجال فن التجويد فقد أكثروا منه جدا حتى تميزوا به عن سائر المدارس، كما امتازوا أيضا بتسجيل الأذان بمقامات عديدة، والإنشاد والابتهالات الدينية، كما أن سفر الكثير منهم لمختلف بقاع الأرض أسهم في انتشار مدرستهم بشكل كبير حتى سميت دولتهم بدولة التلاوة، وقديما قالوا: نزل القرٱن في المدينة، وكتب في اسطنبول، وقرئ في مصر، زد على ذلك اهتمامهم البالغ بكثرة التسجيلات تجويدا وترتيلا بروايات مختلفة، وحسبك بالإمام الحصري الذي قام بتسجيل تسع ختمات قرٱنية، كل واحدة منها تخدم جانبا من كتاب الله.
التحديات والتطورات الحديثة
في الثمانينيات، شهدت المدرسة المصرية بعض التغيرات مع ظهور قراء جدد بدأوا في مخالفة بعض القواعد التقليدية، مثل التنقل السريع بين المقامات أو عدم التنويع فيها، ومع دخول الألفية الجديدة وظهور الفضائيات المتخصصة في إذاعة القرآن الكريم ظهر جيل جديد من القراء يبتعد بمسافة كبيرة عن القواعد التقليدية للمدرسة المصرية، وكانوا أقرب إلى قراء الثمانينيات، حيث أصبح القارئ يتلو دقيقة أو اثنتين من مقام البيات مثلا، ثم يقفز منه إلى مقام الراست، أو النهاوند أو الحجاز أو غيره، وظهر في هذا الجيل تغليب المقامات على الأحكام؛ مما أدى إلى اتساع رقعت النقد محليا ودوليا..
أوجه التشابه والاختلاف بين المدرستين
على الرغم من الخصوصية التي تتمتع بها كل من مدرستي التلاوة الليبية والمصرية، إلا أنهما تشتركان في العديد من الجوانب وتختلفان في أخرى؛ مما يثري فن تلاوة القرآن الكريم.
أوجه التشابه:
أولا: الالتزام بأحكام التجويد:
تتفق كلتا المدرستين على الأهمية القصوى للالتزام بأحكام التجويد الصحيحة، من مخارج، وصفات، ومدود، وغنن، وغيرها؛ لضمان تلاوة خالية من اللحنين، الجلي والخفي.
ثانيا: الاهتمام بتعليم القرآن وحفظه:
تسعى كلتا المدرستين إلى نشر كتاب الله وتعليمه وتحفيظه للأجيال المتعاقبة، وتخرجان أعدادًا كبيرة من حفظة القرآن وقرائه.
وجود قراء متميزين:
أنجبت كلتا المدرستين قراءً عظماء تركوا بصمات واضحة في تاريخ التلاوة، وأثروا العالم الإسلامي بأصواتهم وأدائهم الفريد.
أوجه الاختلاف:
| الميزة | مدرسة التلاوة الليبية | مدرسة التلاوة المصرية |
| الرواية السائدة | رواية قالون عن نافع | رواية حفص عن عاصم |
| التركيز على المقامات | الأداء الطبيعي والصوت الأصيل للقارئ، دون تقليد مفرط، وموافقة المقام من غير تركيز وقصد | التغني بالمقامات الشرقية والانتقال المنظم بينها |
| المنهجية | تعتمد على الأداء الفطري والصوت الشخصي للقارئ مع الصرامة في أحكام التلاوة | قواعد صارمة في الأداء الإذاعي، وترتيب محدد للمقامات |
| التأثير | تأثير إقليمي قوي وخصوصية متقنة في الأداء | تأثير عالمي واسع بفضل الإذاعة وكثرة التسجيلات والتفنن في النغم |
| النمط | الاهتمام والتركيز على نمط الترتيل والتفنن في إتقان الأحكام، مع ندرة استعمال نمط التجويد | الاهتمام بنمطي الترتيل والتجويد مع التركيز على الثاني والتفنن فيه |
تحليل المقارنة .. تنوع الغاية والذوق
من خلال هذه المقارنة نجد أن الاختلاف الحاصل بين المدرستين إنما هو من قبيل اختلاف التنوع لا التضاد، فهما على سبيل المثال بمنزلة الأسماء المتكافئة التي هي بين المتباينة والمترادفة، ويستبين هذا من أمور ثلاثة: الغاية، والطابع، والذوق.
أولا: الغاية:
تهدف المدرسة المصرية إلى “التأثير” من خلال الإتقان الموسيقي ودفق المشاعر، بينما تهدف المدرسة الليبية إلى “الخشوع” من خلال الدقة اللغوية والجدية في الأداء.
ثانيا: الطابع:
الطابع المصري طابع مطربٌ وأنيق، بينما الطابع الليبي صارمٌ ووقور، فالأول يشبه لوحة فنية ملونة بمشاعر مختلفة، والثاني يشبه نقشًا حجريًا عميقًا يحمل روح الأصالة والإتقان.
ثالثا: الذوق:
هنا يكمن سر التنوع، فالمستمع الذي يبحث عن الروعة الصوتية والتأثير العاطفي سيميل إلى المدرسة المصرية، بينما المستمع الذي يبحث عن الهدوء والتدبر والطابع العربي الأصيل سيجد في المدرسة الليبية ملاذًا له.
وهذه المقارنة مفروضة على سبيل ما يغلب، وإلا فالتداخل موجود بين المدرسين، فقد تجد قارئا مصريا مائلا في تلاوته إلى خصائص المدرسة الليبية وبالعكس، كما قد تجد من يجمع خصائص المدرستين، ويظفر بالحسنيين.
خاتمة
في الختام تتجلى عظمة القرآن الكريم في تنوع أساليب تلاوته وتعدد مدارسه – وهذا بلا شك من أعظم أسرار إعجازه – فكل من مدرستي التلاوة الليبية والمصرية تمثلان ركيزتين أساسيتين في خدمة كتاب الله بحسب خصائصها وسماتها التي تعكس تاريخها وثقافتها، فبينما تتميز المدرسة الليبية بأصالة الأداء والتركيز على الصوت الشخصي والعفوية مع إتقان الأحكام، والاهتمام الغالب بنمط الترتيل، تبرز المدرسة المصرية بريادتها في التغني بالمقامات والتفنن في الانتقال بينها، والتركيز على نمط التجويد، مع قواعدها الصارمة التي أثرت في فن التلاوة عالميًا .. هذا التنوع ليس إلا دليلًا على ثراء الثقافة الإسلامية وعمقها، مما يدعو إلى تقدير كل جهد يبذل في سبيل إتقان تلاوة القرآن والتدبر في آياته، فالهدف الأسمى واحد وهو إيصال كلام الله تعالى بأبهى صورة وأعمق تأثير يلامس القلوب وينعش الأرواح.
فمدرسة التلاوة الليبية والمصرية هما وجهان لنقاء واحد، وروحان لكتاب واحد، وهذا التنوع هو بمثابة نعمة كبرى
تثري تجربة الاستماع إلى القرآن الكريم وتوضح كيف أن كلام الله تعالى يتسع لثقافات الأمم وطبائعها وخصائص أصواتها ولهجاتها، دون أن يمس ذلك قدسيته أو أحكامه، فلو فرضنا استعمال فنون الأداء وأساليب التلاوة المعروفة عند القراء في كلام ٱخر غير القرٱن لازداد بذلك قبحا وسوءا، فالحمد لله الذي جعل كتابه معجزًا في لفظه ومعناه، متعددًا في أدائه وأساليب تلاوته، يسع كل القلوب بلغة الروح والجمال، والعظمة والإجلال.
***
كاتب المقال: محمد عمران.