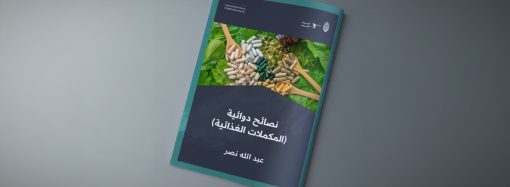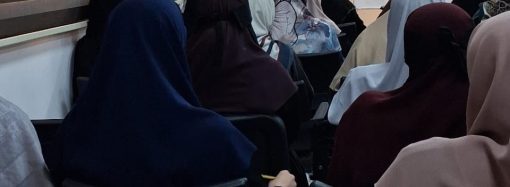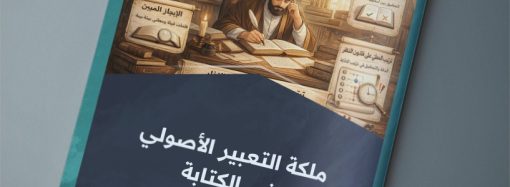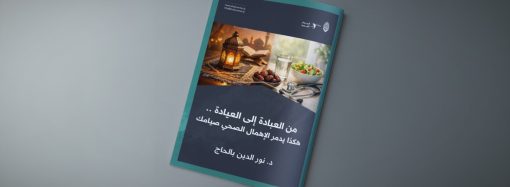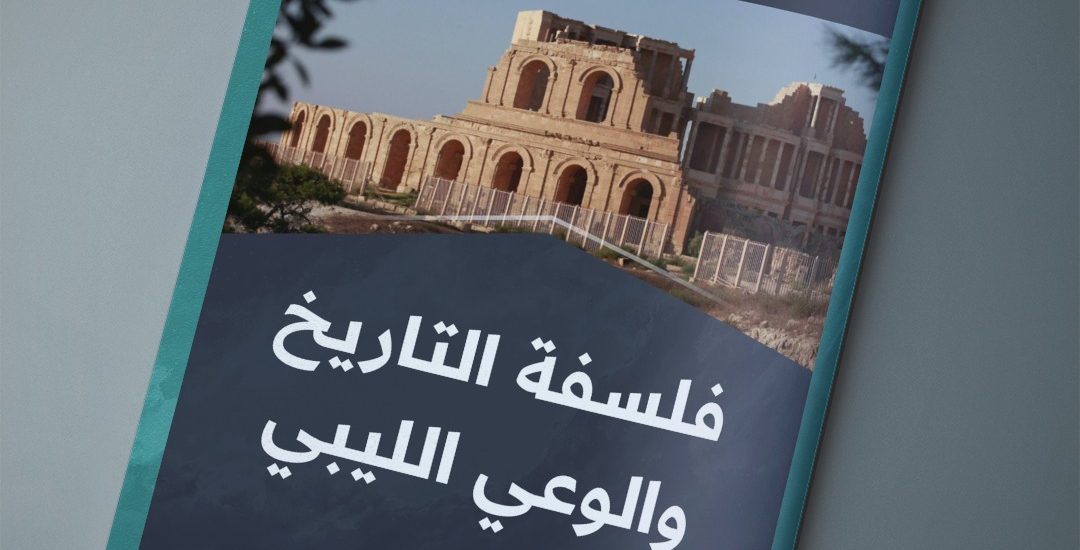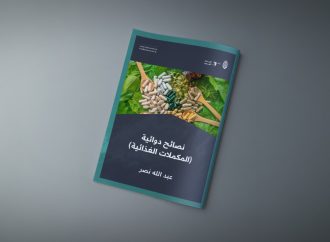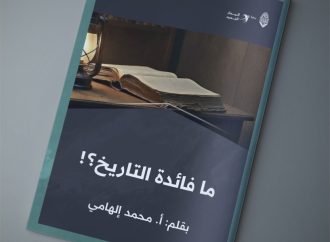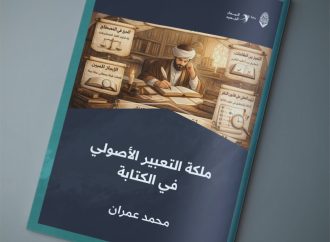فلسفة التاريخ والوعي الليبي
بقلم: د. نجاح بن زايد.
تواجه ليبيا اليوم أزمة في علاقتها بتاريخها، ليس بسبب غياب السرد التاريخي، بل نتيجة افتقاره للتأويل الفلسفي؛ فالتاريخ يُستدعى في الخطاب العام كأرشيف قبلي أو مادة للاتهام، وليس كحقل للتفكير النقدي تتجلى هذه الأزمة في التراكم التاريخي، بعيدًا عن عقل النقد وروح المصالحة؛ أي تراكم للسرديات والأحداث دون أدوات تأويل قادرة على تفكيكها. والنتيجة أن الوعي الجمعي يعيش في حالة تكرار مستمر، يعيد فيها إنتاج الماضي نفسه بأسماء وصور جديدة، وكأن الزمن الليبي لا يتحرك إلا في دائرة مغلقة من إعادة التمثيل والاتهام والتبرير.
يقول هيجل في كتابه فلسفة الحق: «إن بومة مينيرفا لا تطير إلا بعد أن يحلّ الظلام»، أي إن الفلسفة لا تبدأ إلا بعد انقضاء الفعل وانتهاء الحدث، حين يتحول الزمن إلى تأمل. لكن في السياق الليبي، يبدو أننا لم نسمح لبومة مينيرفا أن تطير أصلًا؛ فما زال التاريخ يُخاض بعواطف المنتصر أو عواطف المظلوم، دون أن يُتاح للعقل الناقد أن يتدخل.
وفي ظل غياب هذه المسافة الضرورية بين الحدث والفكر، يتلاشى الأمل في بناء رؤية نقدية تتجاوز الانفعال الآني إلى الفهم العميق للماضي وأثره في الحاضر يؤكد ابن خلدون في مقدمته أن «المغلوب مولع أبدًا بتقليد الغالب»، وهي ملاحظة تنطبق على الواقع الليبي بوضوح، إذ لا يكون التقليد مقتصرًا على المظاهر الاجتماعية فقط، بل يمتد إلى أنماط التفكير والسلطة وآليات التهميش. نحن لا نعيد إنتاج الماضي فقط، بل نستنسخ النماذج المهزومة ذاتها بوجوه جديدة في بُنى قبلية وجهوية. وهنا تكمن مأساة التاريخ الليبي المعاصر؛ فهو يعيش تحت هيمنة الذاكرة، وليس في وعيها، حيث تتحول الذاكرة إلى أداة لإعادة إنتاج التوتر بدل أن تكون وسيلة للتحرر منه.
من يتأمل التاريخ الليبي الحديث، خاصة بعد عام 2011، سيلاحظ تكرار النزاعات ذاتها بأشكال مختلفة. كل مشروع مصالحة أو انتخابات هو، في جوهره، إعادة سرد لسرديات التقسيم والصراع، لا يتجاوز الخلاف بأي شكل من الأشكال. فالمصالحة في صيغتها المتداولة تتحول إلى شعارات سياسية أكثر من كونها فعلًا ثقافيًا أو وعيًا تاريخيًا.
ويمكننا هنا الإشارة إلى فشل لجان المصالحة المتعددة في تحويل التوصيات إلى ممارسات واقعية، بسبب غياب رؤية فكرية تؤطر الذاكرة المشتركة. حتى في الميدان الثقافي، ما زال الخطاب العام أسير ثنائية «الشرق والغرب» أو «الثورة والنظام السابق»، دون تجاوزها إلى سؤال أعمق عن طبيعة المواطنة والهوية الجامعة.
يذكرني هذا بما جاء في كتاب الذاكرة، التاريخ، النسيان لبول ريكور، والذي يقول فيه: «إن التاريخ لا يبدأ من الحياد، بل من الاعتراف بالجرح». الجرح هنا ليس مجرد ألم، بل شرط للمعرفة. ومن دون مواجهة الذاكرة بكل ما تحمله من عنف وظلم واستبعاد، لا يمكن بناء مصالحة حقيقية.
وهذا ما نحتاجه في ليبيا اليوم: شجاعة الاعتراف بدل التجميل السياسي، ومصارحة الذات بدل اللجان الشكلية التي تُفرغ المصالحة من معناها الأخلاقي. الجرح بهذا المعنى ليس ما يُخفيه المجتمع، بل ما يكشف حدود وعيه بنفسه. وبالتالي، تكون كل محاولة لإخفائه هي ببساطة تمديدًا للأزمة دون تجاوزها.
في هذا السياق، يمكن الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى؛ على سبيل المثال: تجربة جنوب إفريقيا في لجان الحقيقة والمصالحة سنة 1995، التي حولت الاعتراف إلى ممارسة اجتماعية علنية، وقامت على العدالة التصالحية بدلًا من العدالة العقابية. أو التجربة المغربية في الإنصاف والمصالحة سنة 2004، التي ربطت بين الجرح والذاكرة الثقافية، واعتمدت على الحقيقة التصالحية بدلًا من الحقيقة القضائية. وكلاهما أمثلة واضحة على توظيف فلسفة الاعتراف لتجاوز التاريخ الجريح نحو أفق وطني جامع.
غير أن تجاوز الأزمة الليبية يتطلب أكثر من المقارنات؛ فهو يستدعي بناء علاقة جديدة مع التاريخ، تقوم على الفهم لا على التبرير.
ويمكننا، في هذا السياق، اقتراح عدة مسارات عملية لتأسيس فلسفة تاريخية نقدية تسهم في بلورة وعي جديد بالذات والذاكرة:
أولًا: إعادة بناء الخيال التاريخي عبر التعليم والإعلام.
إدماج فلسفة التاريخ في المناهج التربوية، بما يعني تطوير طريقة التفكير في الماضي بوصفه سؤالًا فلسفيًا، لا مادة للحفظ. يمكن للمدارس والجامعات أن تنشئ وحدات دراسية تربط بين التاريخ والفكر النقدي، وأن تشجع الطلبة على دراسة شخصيات ليبية من زوايا تحليلية جديدة، مثل علاقة السنوسية بالحداثة أو تحولات الهوية في المدن الحدودية. أما الإعلام، فبإمكانه أن يلعب دورًا مهمًا في تحويل البرامج الوثائقية والتاريخية إلى فضاءات للنقاش النقدي حول الهوية والذاكرة، بدل أن تبقى مساحات استقطاب سياسي.
ثانيا: خلق فضاءات للحوار الفلسفي والتاريخي عبر دعم الجمعيات والمؤسسات الفكرية التي تضم مؤرخين وفلاسفة ومفكرين، لتفعيل النقاش حول الذاكرة الوطنية والمصالحة بوصفهما مجالين للفكر، لا للعاطفة السياسية. يمكن لهذه المؤسسات أن تنظم منتديات فكرية دورية تجمع بين الأكاديميين وصناع القرار والفاعلين الاجتماعيين، بحيث تتحول الفلسفة إلى وسيلة لصياغة سياسات عامة قائمة على الفهم النقدي للماضي، لا على العاطفة أو الأيديولوجيا.
ثالثًا: دعم البحث العلمي والنقدي بتشجيع الدراسات الأكاديمية التي تتناول التاريخ الليبي من منظور فلسفي متعدد السرديات، بعيدًا عن الخطاب الأحادي أو الانتماء الجهوي. ويشمل ذلك تمويل مشاريع بحثية ميدانية في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الثقافية لرصد تحولات الهوية في المجتمع الليبي المعاصر، بحيث يُعاد قراءة التاريخ المحلي بوصفه تجربة إنسانية، لا صراعًا سياسيًا. كما يمكن إنشاء مراكز بحث متخصصة في «دراسات الذاكرة الليبية» على غرار المراكز الدولية المهتمة بالعدالة الانتقالية والتاريخ الشفوي.
رابعًا: التفكير في إعادة تأويل الرموز الوطنية والتاريخية لإحياء الخيال الجمعي كركيزة للهوية المشتركة، بعيدًا عن الفرقة والانقسام. فإعادة قراءة الرموز لا تعني تسيسها من جديد، بل تأويلها فلسفيًا بوصفها علامات على إمكان الوحدة رغم الاختلاف، كما هو الحال في تجارب شعوب استطاعت أن تصنع من رموزها ذاكرة مشتركة تتجاوز حدود الجغرافيا والانتماء.
لا يمكن للمصالحة الوطنية أن تقوم، بأي حال من الأحوال، على طي الصفحات دون قراءتها؛ فكل مصالحة لا تعبر من بوابة النقد هي تسوية مؤقتة، وليست تجاوزًا للتاريخ. لأن الفهم الفلسفي للتاريخ لا يقتصر على إعادة كتابة الوقائع، بل يتطلب إعادة تأصيل السرديات الكبرى التي شكّلت وعينا الجماعي، وتحريرها من منطق التبرير إلى منطق الفهم ولعل قيمة التفكير التاريخي تكمن في قدرته على إنتاج مسافة تأملية بين الذات وزمنها، بحيث لا تعود أسيرة الحدث، بل قادرة على قراءته واستيعابه.
ويبقى السؤال الفلسفي مطروحًا: هل نستطيع، كليبيين، أن نؤسس فهمًا فلسفيًا للتاريخ يحررنا من كوامن الماضي ويمنحنا القدرة على بناء مستقبل نقدي متصالح؟ وهل نملك الشجاعة لإعادة صياغة سرديتنا الوطنية بما يتناسب مع تطلعاتنا نحو العدالة والمعرفة؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا تكمن في إعادة كتابة التواريخ، بل في إعادة التفكير في معنى التاريخ نفسه، وأن نعي أن الزمن ليس ما مضى، بل ما يمكن أن يُعاد تأويله في ضوء الحاضر والمستقبل. ومتى ما طارت بومة مينيرفا في سماء ليبيا، سيكون الإعلان عن ميلاد الوعي الفلسفي بتاريخنا.