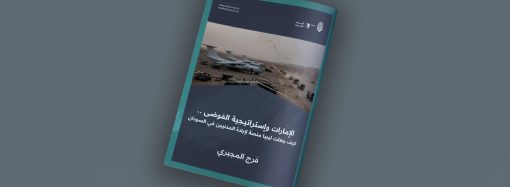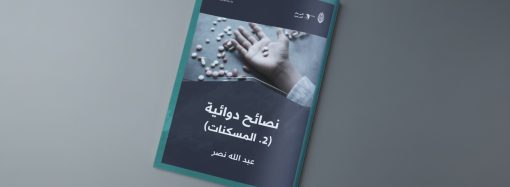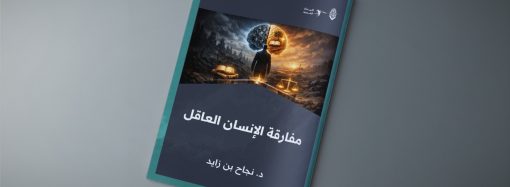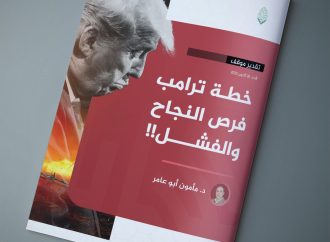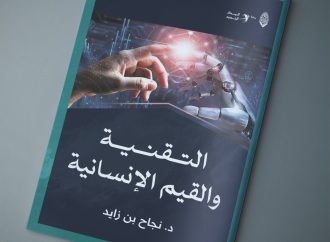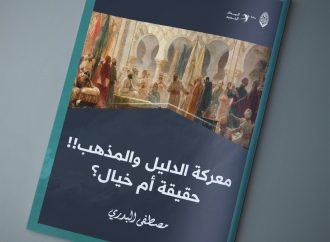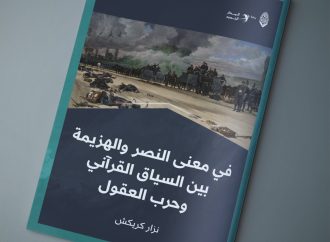مقال بعنوان: (( لماذا يغيب صوت المصلحين؟ ))
بقلم: عبد الله علي أحمد نصر.
بسم الله الرحمن الرحيم
لماذا يغيب صوت المصلحين في وقت تعالت فيه أصوات التافهين؟ ألا تبدو الساحةُ اليومَ شبهَ خاليةٍ من المؤثرين المصلحين في ظل طغيان من ينشرون التفاهة والأخلاق الذميمة في المجتمع؟ انظر حولك وتصفّح وشاهد؛ ستجد أنَّ المحتوى الأبلغ والأكثرُ انتشاراً هو الذي يحملُ في طياته الرذائل وما لا قيمةَ له، أو -في أحسن الأحوال- كل ما هو تافهٌ لا ينفع الإنسان في دينه ولا دنياه. بينما حضور المصلحين محدودٌ لا يبلغ الجميع.
إن المُصلح في المجتمع كالطبيب، فهو أبصر الناس بالأمراض والظواهر الهدامة التي تتفشى بين الناس، هو أعلمهم بها، وبحقائقها وبمدى أضرارها وخطرها عليهم، ثم هو من بعد ذلك أخْبَرُ الناسِ بطرق التصدي لها، وعلاجها إن انتشرت واستفحلت، وهو كذلك الذي يستطيع تحديد مدى صحة المجتمع من عدمها، وتوقُّعَ الأخطار التي تتهدده في مستقبله القريب والبعيد؛ كيف لا وهو أعلمُهم بحكم الله في المسائل التي تعترضُ الناس كل يوم، وهو أدراهم بما قال الله -تعالى- وما قال رسوله -صلى الله عليه وسلم-. وكما أن دور الطبيب الفاعل -الذي يخرُج من عيادته ويرصُد المعطيات والنتائج التي تساهم في انتشار الأمراض في المجتمع-، ليس كَدور الطبيب المنزوي على نفسه في عيادته أو مَخبره، فلا يخفى أن ألأولَ أنفعُ للناس وأبلغُ أثراً من الثاني؛ فكذلك المُصلحُ الذي يخرجُ للناسِ ويحتكُّ بهم، ويحاورهم ويحادثهم، ويُراقِبُ ما يُذاعُ ويُشاعُ في أوساطهم، ويرصُدُه ويحلِّلُه، أنفعُ لهم من ذاك الذي يبقى حبيسَ المسجد والدوس والمجالس العلمية، وقد رتَّب النبي -صلى الله عليه وسلم- الأجر الأعظم على مخالطة الناس؛ فقال: (المؤمنُ الَّذي يخالطُ النّاسَ ويصبِرُ على أذاهُم خيرٌ منَ الَّذي لا يخالِطُ النّاسَ ولا يصبرُ على أذاهم).
والناظرُ في حياة الناس اليومَ يرى أن أموراً أو أحداثاً تَطراُ في الدنيا، فيشيعُ ذكرُها ويذيع وتحوزُ نصيباً من اهتمام الناس، لا سيَّما على وسائل التواصل الرقمي، وإنك إن تأمَّلتَ رأيت الناسَ أغلبَهم يخبطون فيها على غير هدى؛ فيتبعون مصالحهم أو أهواءهم فيقولون ما لا يعلمون وينصرون الباطلَ ويخذلون الحق، بعلمٍ منهم أو بجهل، ويستوي فيهم الجاهل بالعالم، لا يفضُل أحدُهما إلا بأعداد متابعيه وبما يملك من تقنيات ووسائل توصل صوته إلى الآفاق، وتجعل رأيه مُتّبعاً، وتُصَيِّرُه قدوةً لغيره. وهنا يأتي دور العالم المُصلح، فهو الذي يعيدُ تعريف الأمور (على نورٍ من الشريعة)، فيُبيِّنُ للناس حقائق الأشياء، وقيمتها في ميزان الحق، فيتَسنّى على إثر ذلك، لكل من أرادَ صدقاً اتِّباعَ الحقِّ أن يتَّبعَه.
إلا أننا إن نظرنا مجدداً إلى ما يُطْرَحُ لوَجدنا وجودَ هؤلاء المُصلحين محدوداً إذا ما قِسناهُ إلى كثرتهم في المجتمع -ولله الحمد-، وعندما أشيرُ إلى كثرتهم، فلستُ أعني المبتدئين منهم والذين مازالوا في مراحل التأسيس العلمي والتربوي، بل أعني الطبقةَ التي يُناطُ بها تصحيح المفاهيم، وربطُ أحكام الدين بحياة الناس اليومَ في صورةٍ واضحة للجميع، قريبةٍ منهم. وإن شئتَ تذكَّر معي أي قضيةٍ أُثيرت في الأيام القريبة الماضية واستحضِر الأصوات التي عَلتْ فيها، ثم اذهب إلى قضية أخرى وافعل ذات الشيء، وكرر مع ثالثةٍ ورابعة؛ ستجدُ صوت المصلحين الأخيار هو الأبعدَ والأخفضَ، والأقلَّ سماعاً واتِّباعاً؛ لا سيَّما بين الشباب.
ولعلَّ أسباب ذلك كثيرةٌ متداخلةٌ متَشعبة؛ وأوَّلُها ورأسُها وأُسُّها: غياب المنهج، أعني المنهج الإصلاحي بين طلبة العلم الشرعي، أو عدمَ وضوحه أو جدِّيَّته، وإن شئتَ قل: عدم تمثُّل الإصلاح كأولوية شرعية في حياة الناس اليوم. فإن نظرت إلى سلم الأولويات عند طلبة العلم الشرعي؛ لوجدتَ أكثرَهم يهدف إلى الغوص في بحار العلم والأخذ منه بنصيبٍ وافر، ووجدتَ البعضَ يسلك هذا السبيلَ تحقيقاً لرغبةِ والدٍ حال الزمانُ دونه أن يبلُغ هو ما يؤمِّلُ في ابنه، ومن هؤلاء الطلبةِ من يتحمل مشاقَّ العلم اليومَ ليصيرَ غداً شيخاً معلماً لأجيالَ تأتي فتسلُك نفس السبيل. وكُلُّها أهدافٌ ساميةٌ نبيلةٌ، حقيقةٌ بأن يبذُلَ الإنسانُ فيها حياته محتسباً أجرها عند الله. ولكن؛ إن كان هذا قُصارى الآمال، فَمَن الذي يأخُذُ بهذه المهَمَّةِ العظيمة: الإصلاح؟ إنَّ من الظلم أن يُنظَر إلى مخالطة الناس -والاحتكاك بهم بنية الإصلاح- على أنه منقَصَةٌ تلحق الشيخَ، أو مثلمَةٌ في علمه أو مكانته! إنَّك إن قرأتَ قَصص الأنبياء في القرآن وجدت عُنوان رسالتهم الأكبرَ: إصلاحُ الناس؛ بدءاً من تصحيح عقيدتهم وتوجههم إلى الله خالقهم ورازقهم، انتهاءً إلى تعليمهم كيف يأكلون ويشربون، مروراً بإصلاح معاملاتهم فيما بينهم لتسير وفق شرع الله.
ولعلَّ سبباً آخَر يكمُن وراءَ هذا الانحسار (إن صحَّت التسمية)، هو لُحوق الضرر بهم إثر ارتفاع أصواتهم بالإصلاح أو حتى الدعوة إليه. والحقُّ أنَّ هذا الضررَ في أغلب الأحيان حاصلٌ مُشاهَد، وأقلُّه: استهزاء أفرادٍ من الناس بهم، والسعيُ في بيان مثالِبهم وهفَواتهم بحقٍّ وبغير حق، ولا أرى هذا إلا بدعم وتحريشٍ من دُعاة الرذائل داخلياً وخارجياً؛ فَكم من شيخٍ خرجَ وتكلَّمَ عن ظاهرةٍ شاعت بين الناس، وبَيَّن لهم فيها حكم الله وشرعه، وبسطَ لهم القولَ نصحاً وإرشاداً، فانهالت فئةٌ من الناسِ عليه: هذا يستهزئُ بمظهره ويصفه بعدم اللباقةِ واللياقة، وهذا يُبدِّعه ويكادُ يُخرجه من الإسلام، وآخرُ يتَّهم نواياه وينسبُه إلى جماعةٍ معينة. والأدهى في هذا الهُجومِ أنه لا يُناقشُ الفكرةَ أو القولَ، ولا يدحَضُ الحُجَّةَ بالحجة، بل هو هجومٌ تدميريٌّ لا يهدفُ إلا إلى إحباط المصلحين! وضَرَرٌ آخر هو أشدُّ وطأةً وأفتكُ بكل مُصلحٍ، وهو سطوةُ الحُكَّام وغياهب السجون؛ فقد دأبَت بعضُ السُّلُطات على إخمادِ أي صوتٍ يوقِظُ الوعيَ أو يُعيدُ إلى الناسِ رُشدَها، وهذا ليس من خصائص عصرنا فقط، فهو قديمٌ مُمتدٌّ امتداد تاريخ هذه الأمة.
على أن خُفوتَ صوت أهل الإصلاح قد يكون منهم أنفُسهم، فإنك ترى بعضَهم يَنبُغُ في علم ويقوى عودُه فيه، فيتأهَّلُ بذلك لأن يكون الناصح الأمين لقومه، فما يكونُ منه إلا أن يغرق في صراعاتٍ فيما بينه وبين أقرانه على فروعٍ من العلم، بينما الناسُ من حولهم في تَيه وضلال يُحوِجُهم إلى من يَدُلُّهم ويقودُهم في منعرَجات الطريق التي تعترضُهم. وهذا التصارُع والتصادُمُ يودي بهم من أكثرَ من وجه: فهو أولاً مَهلكَةٌ لِأوقاتهم ومُضيِّعٌ لجهودكم، فبدلاً من أن ينشغل الواحدُ منهم بفهم واقعه وتحليله، تراهُ ينشغلُ بالرد على فُلان وعِلّان على مسألةٍ وَسِعَ الأوَّلونَ الاختلافُ فيها بِوُدٍّ. ثُمَّ إنَّ هذا التصارُعَ يُذْهبُ هيبةَ أهل العلم في أعين الناس؛ فيصِيرونَ أهلاً للشقاق والخلاف والهدمِ، وهم في الحقيقةِ أهل البناء والصلاح والإصلاح. فانشغالهم بهذا يُعَدُّ من قبيل الانشغال بالمفضولِ عن الفاضل.
كما أن إحجام بعضَ طلبة العلم والعُلَماء عن الإدلاء برأيه -بعد التمكُّنِ مما يتكلم فيه- قد يرجعُ إلى تطلّبه الكمالَ، وخوفه من النُّقصانِ، والحقُّ أنَّ الكمالَ مُتعَذِّرٌ مهما حاولَ ومهما بذل، وأنَّ الإنسانَ وإنْ بلغ في العلم أقصى ما يُؤمِّل، وإن خاضَ من التجارِبِ ما يُشيِّبُ الولدان، ومهما خالطَ من بني البشر، ومهما سعى وحاولَ، ومهما صحَّحَ ونقَّح، ومهما استشارَ واستخارَ، فإن المثاليَّةَ وهمٌ لنْ يبلُغَه ولن يُدانيه، وإنما يكفيه السعيُ في التعلُّمِ التحصيل، واكتسابُ الخبراتِ في التعامل مع الناس والتأثير فيهم.
وأما خشيةُ النقصانِ فإن الإنسانَ بطبعه ناقِصٌ ضعيف، وأنه بسعيه على قدر استطاعته يكون قد أعذَر نفسه أمام ربه، وأمام مجتمعه. ثُمَّ إنه متى كان مُخلصاً لله، آخذاً بأسباب العلم والدراية والخبرة والتحليل، فإن الله يُسَدِّده ويُباركُ عملَه؛ فيلقى من إقبال الناسِ عليه واستجابتهم لدعواه وتوجيهه ما لم يَكُنْ يُؤمّلُه، وسينالُ كذلك من دعاء الخير بظهر الغيب الكثيرَ على ما يُسديه في سبيل الله، وإن تخَلَّل ذلك كله حرباً شعواءَ من دُعاة الرذيلة ورُعاتها، واستهزاءً من الحاسدين الذين يكرهون أن يروا نعمة الله على أحد، وتضييقاً من ذوي الشوكة، فإننا نرى اليومَ أعياناً من المصلحين صبروا وثبتوا، فأثابهم الله في الدنيا بأُناسٍ التفَّتْ حولهم، ونهلت من تجارِبِهم، كما أنَّ عامَّة الناس تلَقَّتْ كلامه بالقَبول والترحيب. فليصبرْ وليحتَسب، وليَقدُرِ الأمورَ قدرَها، ويزنَها بميزانها، فيدري متى يُقدِم ومتى يُحجم، وأسوته في ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأنبياءُ من قبله، والمصلحون على مر الزمان.
وأمرٌ آخرُ قد يأخُذُ العالِمَ أو طالبَ العلم بعيداً عن ميدان الإصلاح، ويجعُلُه حبيسَ الدروسِ والنقاشات العلمية أو الأكاديمية أو الفكرية البحتة، بعيداً عن الناس وما يخوضون فيه، وهو اعتقادُهم بأنَ طالبَ العلمِ لا بُدَّ أن يكونَ في منأىً عن عامة الناس، وأنَّ احتكاكَه بهم يُعيقُه في سبيل التعلم والتأدُّب، وقد يملأُ قلبَه بحُبِّ الدنيا وحب الخوض فيها، أو أن ذلك مدعاةٌ للسمعة والرياء. وأنَّه متى انحَسَرَ عنهم فإنَّ شتاتَ نفسِه يلتَئِمُ، وصفاءَ رُوحهِ يُحْفظ، ويتّقِدُ ذهنهُ؛ فينْهلُ من بُحور العلمِ ما قَسَم الله له، ويسهُلُ عليه أن يتخلَّقَ بأخلاق أهل العلم الفاضلة.
والحقُّ أن هذا الكلام فيه وجهٌ من الصحة، ولكن كلُّ شيءٍ بِقدَرٍ! فإنَّ نهج الأنبياء -كما أسلفت- كانَ الاختلاطَ بالناسِ في أسواقهم كما فعلَ شعيبٌ -عليه السلام-، إذ نهى قومَه عن تطفيف الموازين وأخذ المُكوسِ من الناسِ ظُلماً وعُدواناً. وإنّ نهج الأنبياء الاختلاطُ بالناس في معابدِهم كما ان نوح -عليه السلام- إذ نهى قومه عن عبادة الأوثان الأصنام، بل إن من نهجهم تحطيمُها وتهشيمها ومُحاجَّة القوم كما فعل الخليلُ إبراهيم -عليه السلام-. وإنَّ نهجَ الأنبياء الاختلاطُ بالقوم في نواديهم ونهيهُم عن الطُّغيان والعُتُوِّ وعبادة غير الله، كما فعلَ رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- مع قريش في مكة، ولنتأمل قليلاً في سيرتِه لِنَرَ: فعندَما أُمِرَ النبي -صلى الله عليه وسلم- بالجهر بالدعوة نادى في قومه قبيلةً قبيلةً، داعياً إياهم بلسانٍ فصيحٍ صريح: أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئاً! فكَذّبوه وآذوه؛ فما مَلَّ ولا كَلَّ. بل ذهب إلى الطائف ودعا أهلها إلى دين الله دعوةً واضحةً جليةً، فكذَّبوه ونالوا منه؛ فصَبَر! فعادَ إلى مَكَّةَ في جوار سيّدٍ من أهلها؛ فهل كَفَّ وانتظَر النصْرَ من الله بمُعجزة؟ كلا والله، إنما واصلَ مسيرةَ الدعوة عارضاً نفسه على القبائل التي تقصدُ مكَّةَ للحج، يدعوهم إلى دين الله الحق، ولا يخفى أن في هؤلاء الناسِ كرَامٌ وفيهم لئام، وفيهم من قد ينالُ منه أو يُبَيِّتُ له نيَّةً خبيثةً، ناهيكَ عن قُريشٍ التي تفعلُ كل ما في وسعها لتصدَّهُ عن الناسِ وتَصُدَّ الناسَ عنه، فصَبرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى حَظيَ بالأنصار مُبايِعينَ. فهذا هو المنهج!
ثُمَّ إن المُصلِحَ متى أزاحَ نفسه عن مكانه الذي أقامه الله فيه، وانشغلَ بما دون ذلك، فإن أهلَ الباطلِ ينتشرون كالحشائش فيملؤون مكانه، ويبُثُّون سمومهم للناسِ في صورة مُزينةٍ مُبهرجة، تخدع غالب الناس وتقودهم إلى حبائلها، فيسيرُ الناسُ في أعقاب الباطلِ، وتُخمَدُ أي جذوةِ خيرٍ في نفوس أبناء الأمة، ويُخيّم اليأسُ على قلوب الشباب خاصةً، فتنتَشِرُ بينهم الظواهرُ الهدّامة في الفكر والسلوك، ولا يعودُ أمرٌ بمعروفٍ ولا نهيٌ عن منكرٍ إلا لِماماً.
وأخيراً أقول لأهل الإصلاح: سيروا في الدرب، مستَنِّين بسُنَنِ الأوائل، مُستنيرين بنورهم، لا يُزعِجَنَّكم استهزاء السُّفهاء. ولا تستبْطئوا الثمَرات، ولا تقيسوا نجاحكم بمقاييس أهل الدنيا، فإنَّ اللهَ مُجزيكُم على أعمالكم لا على نتائجها، فكم من نبيٍّ قُتل، وكم من صحابيٍّ مات والمسلمون في قلة وضعف، وكم من مصلحٍ نالَ منه السفهاءُ ما نالوا. (وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ اُ۬لْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَۖ).
عبد الله علي أحمد نصر
13-4-1447 ه
5-10-2025 م