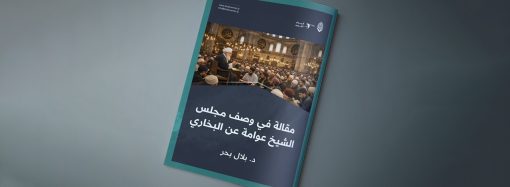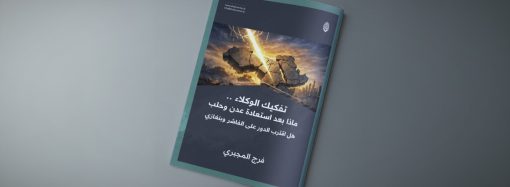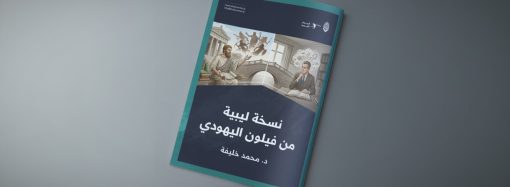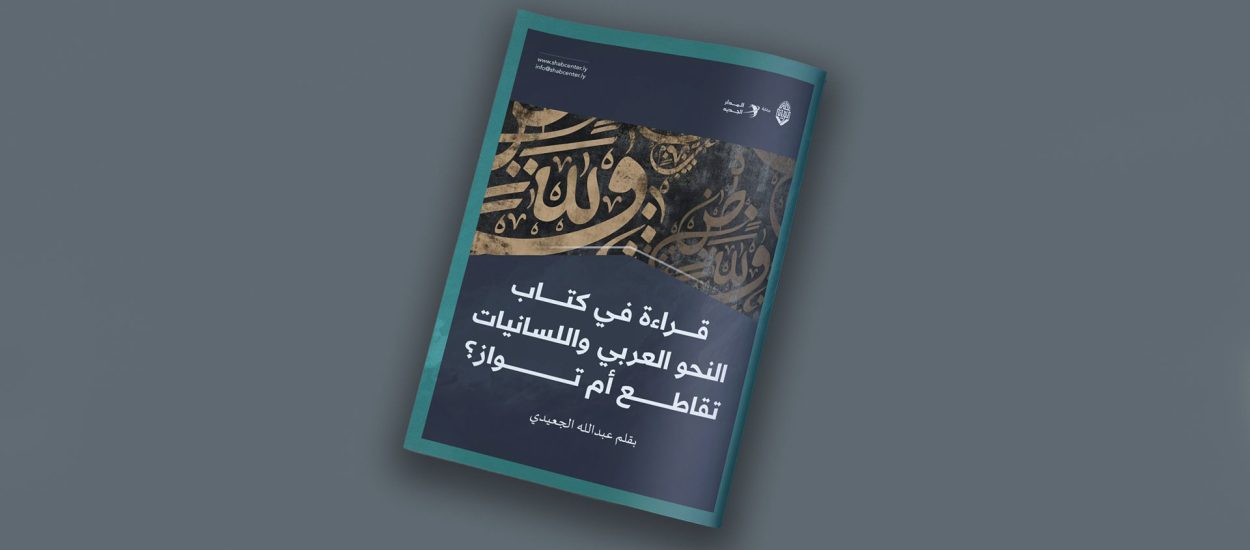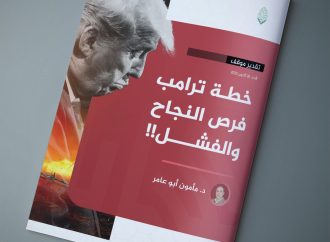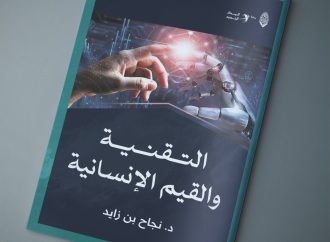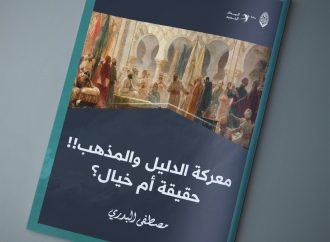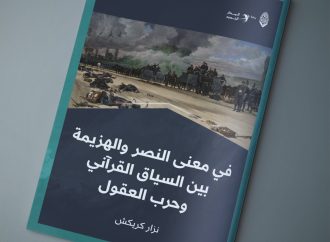قراءة في كتاب: ( النحو العربي واللسانيات تقاطع أم تواز )
العنوان : النحو العربي واللسانيات تقاطع أم تواز
دار النشر : تكوين للدراسات والأبحاث بريطانيا
الطبعة : الطبعة الأولى
تاريخ النشر : عام 2016
عدد الصفحات الكتاب : 416
المؤلف:
هو: أ.د. عبدالله الجهاد أستاذ التعليم العالي محال على المعاش – جامعة الحسن الثاني كلية الآداب والعلوم الانسانية عين الشق المملكة المغربية
مستوى القراءة والتحليل
(1)
إشكالية الكتاب :
الإشكالية التي يعالجها الكتاب كما عبر عنها في ص 21 هي : هل للنحو العربي نظرية ؟ وهل له منهج محدد في تعامله مع المادة اللغوية ؟ وما هو الفرق بين نظرية النحاة العرب القدماء ونظرية اللسانيين المعاصرين ؟
(2)
أطروحة الكتاب :
يحاول المؤلف بيان نظرية النحو العربي عند النحاة العرب القدماء ومناهجهم في التحليل ومقارنتها بمشاريع لسانية معاصرة من خلال عرض دراسات نقدية للسانيين عرب من الاتجاه الوصفي والاتجاه التحويلي ويبين مواضع القصور في هذه الدراسات ويدافع عن وجهة نظر النحاة القدامى .
(3)
هل للنحو العربي نظرية متكاملة ؟
بدأ الكاتب في المقدمة بذكر أهمية كتاب سيبويه في نشأة النحو باعتباره هو مؤسس بناء النحو العربي وما جاء بعده من كتب هو لتفسيره أو تبسيطه ولم تخلو العصور بعده من نقد له ولكنها قليلة كما فعل ابن مضاء القرطبي في مؤلفه “الرد على النحاة” وهو نتيجة لغلبة المنهج الظاهري في عصره .
وجعل المدخل للإجابة عن سؤال : هل النحو العربي اعتمد الوقائع اللغوية أولًا ، ثم صاغ نظريته النحوية أو أن النحاة العرب كان لهم تصور نظري سابق حاولوا أن يشغلوه في تحليلهم اللغة العربية ؟.
وخلاصة جوابه بحسب سياق كلام الكاتب في وصف المنهج العلمي بأنه منهج استقرائي استنباطي في نفس الوقت قال : ” أن المنهج العلمي يعتمد مجموعة من الافتراضات المسبقة والمباديء العامة ، يحاول الباحث تجريبها على الوقائع ليستخرج منها إذا صلحت أزمنة وأمكنة متعددة ، قوانين عامة مصوغة في قوالب رياضية تستثمر في وقائع أخرى لم تمارس عليها هذه الفروض . أو يمكن التنبؤ بوساطة هذه القوانين بوقائع جديدة ” ص18
ويأتي السؤال المركزي في البحث وهو : هل للنحو العربي نظرية ؟ وهل له منهج محدد في تعامله مع المادة اللغوية ؟ وما هو الفرق بين نظرية النحاة العرب القدماء ونظرية اللسانيين المعاصرين ؟
وللجواب عن هذا السؤال خصص المؤلف الباب الأول لنظرية النحو العربي في خمسة فصول بيّن في الفصل الأول الكلام العربي الفصيح ومصادره من النقل الصحيح والسماع وفي الفصل الثاني القياس وأنواعه وفي الفصل الثالث العلة عند النحويين وأنواعها وفي الفصل الرابع استصحاب الحال ويعتبر هو الأساس لفهم نظرية النحو العربي كما يقول في ص 111وفي الفصل الخامس العامل وأقسامه .
وسبب الإطالة في بيان نظرية النحو العربي بيّنه بقوله : ” لقد حاولنا في هذا الباب أن نبين الخطوط الكبرى لنظرية النحو العربي لأنها كانت هي المستهدفة نقدا في المؤلفات اللغوية المعاصرة ” ص 134
إذن هذه الإطالة في تفصيل معالم نظرية النحو العربي لكي تكون تمهيدا لذكر أوجه النقد عند بعض المعاصرين ولكي تكون النظرية محل النقد واضحة المعالم عند القاريء .
نظرية النحو العربي في المؤلفات الحديثة من خلال اتجاهات لسانية :
وفي الباب الثاني وهو المخصص لنقد نظرية النحو العربي عند بعض المعاصرين وعنون له الكاتب : “نظرية النحو العربي في المؤلفات الحديثة من خلال اتجاهات لسانية ” .
مهّد المؤلف بذكر تحقيب تاريخي مختصر لمؤلفات النحو العربي بدءا من سيبويه في الكتاب وانتهاءا بابن هشام في مغنيه وابن مالك في ألفيته ثم قال : ” وخمل ذكر النحو فأصبحت سمة النحو عارا على حاملها إلى أن ظهر العصر الحديث ” ، وهنا لم يحدد بداية زمن العصر الحديث لكنه عقب على ذلك بوصف حالة التخلف العلمي واستشهد بأحد الرحالة الفرنسيين عن مصر والشرق العربي في أواخر القرن الثامن عشر (1)
وبدأ المؤلف بعوامل النهضة اللغوية غير المباشرة وقد بدأت بحسب قوله بالحملة الفرنسية على مصر والتي كانت بمثابة الصدمة الكهربائية ليأتي بعدها محمد علي ويرسل البعثات إلى أوروبا ونشاط الترجمة في مدرسة الألسن التي كان يشرف عليها رفاعة الطهطاوي .
وأما عوامل النهضة اللغوية المباشرة فترجع بداية لعمل المستشرقين في إخراج المخطوطات وفهرستها وتحقيقها وطباعتها وكان من أهمها الكتاب لسيبويه الذي طبعه المستشرق الفرنسي هرتويغ درنبورغ أستاذ اللغة العربية الفصحى بالمدرسة الخاصة باللغات الشرقية في باريس (1844-1908) .
وكان إنشاء الجامعة المصرية محاولة لجلب رموز علمية من الغرب لتزرع بذورا جديدة في الدراسات اللغوية ومنها سلسلة المحاضرات التي ألقاها برجشتراسر وقد جمعت في كتاب بعنوان : ” التطور النحوي للغة العربية ” الذي طبع سنة 1929م ونقل إلى الجامعة علم اللغة التاريخي وعلم اللغة المقارن الذين ظهرا في الغرب .
ونتيجة للصراع بين الجديد والقديم نشأ الجدل والحوار بين التيار التغريبي والتيار المحافظ ، بين من يُمجّد اللغة العربية ويحاول أن يُبقي عليها ويعدّها لغة حيّة وبين من يرى أنها انتهت بانتهاء العصر العباسي ، وأيضا نشأ الخلاف حول المصطلحات الأعجمية الجديدة هل يجب تعريبها أو إدخالها على علّاتها دون تغيير ؟ ، غير الصراع الثقافي بين من يشيد بالثقافة الغربية ورافضيها .
ويرى المؤلف أن هذه العوامل أسهمت في إحياء النحو العربي أو تجديده أو تقديم البديل .. !!
***
في الفصل الثاني : انتقل إلى استعراض محاولات الاتجاه التقليدي في حل معضلة معاناة تعلم النحو العربي وبدأ بإبراهيم مصطفى مع الإشارة قبل ذلك إلى الإحساس بتعقيد النحو لم يظهر في العصر الحديث فقط ، بل أحس به العلماء ، وعامة الناس منذ زمن بعيد .
صدر كتاب ” إحياء النحو ” لإبراهيم مصطفى سنة 1937م (2) ومشروع إحياء النحو عنده يتمثل في :
- تغيير منهج البحث النحوي للغة العربية .
- تسهيل أصول النحو على المتعلمين الذي يهدف إلى :
أ- تقربهم من اللغة .
ب – هدايتهم إلى الفقه بأساليبها .
ويُرجع المؤلف أحد أسباب الإشكال في محاولة إبراهيم مصطفى لإصلاح النحو في نظره هو اعتماده تعريفا واحدا من تعريفات النحو وهو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء ، وليس هذا هو التعريف الوحيد للنحو عند النحاة ، بل النحاة اختلفوا على عدة تعريفات ولذلك نجد أن نقد إبراهيم مصطفى لتعريف النحاة لا ينبني على صواب ، لأن النحو العربي اهتم بالجملة ومكوناتها ، واستنباط قوانين تأليف الكلام ، فاتهام النحو العربي باقتصاره على أواخر الكلم تجن عليه ، وإذا ما أعطى النحاة العرب قيمة للعلامة الإعرابية فلأنها كانت هي مصدر فساد السليقة الفصيحة .
وناقش المؤلف محاولة لجنة وزارة المعارف المصرية المكونة من أحمد أمين وإبراهيم مصطفى وعلي الجارم ومحمد أبي بكر إبراهيم لوضع تقرير لتيسير تدريس اللغة العربية وبعد مناقشة المؤلف لمقترحات اللجنة قال : ” فهذه الافتراضات لم يكتب لها النجاح ، لأنها لا تمس جوهر النحو ويظل النحو في دقائقه معبرا أمينا عن اللغة العربية التي يصفها ومعبرا عن سليقة المتكلم العربي ” .
ومن المحاولات لتطوير النحو العربي ما قام به شوقي ضيف في سنة 1947م بنشره لكتاب “الرد على النحاة” لابن مضاء القرطبي وتتلخص فكرة شوقي الضيف التي استوحاها من ذاك الكتاب بالانصراف عن نظرية العامل ، ومنع التقدير والتأويل في الصيغ والعبارات وأفكاره لا تخرج عن ما سبقه من آراء إبراهيم مصطفى .
وختم المؤلف استعراض محاولات تطوير النحو العربي بأحد علماء النحو وهو عباس حسن الذي ألف كتابا للتنظير وهو “اللغة والنحو بين القديم والحديث ” سنة 1966م تحدث فيه عن تاريخ اللغة العربية وكيف
تطورت من الولادة إلى طور الضعف وعن القياس والمطرد والشاذ ويرى عباس بأن هناك تناقضا نحويا بين نحو القرآن ونحو النحاة ، ويطرح بديلا وهو وضع نحو خاص لكل قبيلة يساير لغتها أو خيار آخر وهو اختيار القرآن مدونة لغوية ينبني عليها نحو نموذجي .
ويخلص المؤلف بأن :” عباس حسن يعتمد اعتمادا كليا على ما ورد في الكتب النحوية القديمة ولم يستطع التخلص من آسار النظرية العربية القديمة مع شدة انتقاده لها في مؤلفَيه معا ” .
***
وفي الفصل الثالث مهّد المؤلف للحديث عن الاتجاه الوصفي بهذا السؤال : هل يستطيع اللسانيون العرب الذين يتبنون نظريات لسانية معاصرة قطع الصلة نهائيا مع النحو العربي القديم ؟
يقول :” إن اللسانيات ، على اختلاف مدارسها ، تتفرع من أسس واحدة نظرية ومنهجية ” وذكر هذه الأسس :
- أسبقية اللغة المنطوقة على اللغة المكتوبة في البحث اللساني .
- اللسانيات علم وصفي يمر بمراحل ثلاث هي : مرحلة النحو والمرحلة الفيلولوجية ومرحلة النحو المقارن .
- اللسانيات جزء من السميولوجيا .
- اللسانيات تدرس اللغة كبنية وهي خصائص ثلاث : الشمولية ، والتحويلات والضبط الذاتي .
- أسبقية الدراسة السانكرونية في اللسانيات .
- المحور المركبي والمحور الاستبدالي .
ومستويات التحليل في منهج اللسانيات الوصفية عند أغلب اللسانيين بعد جمع المعطيات اللغوية يقسمون الجملة إلى ثلاثة مستويات على الأقل :
المستوى الفونولوجي والمستوى التركيبي والمستوى الدلالي ثم يمرون إلى الدلالة الاجتماعية وهي ارتباط المقام بالمقال وقد نص المؤلف على اهتمامه فقط بالمستوى التركيبي قال :” وبما أن موضوعنا مرتبط أساسا بالمستوى التركيبي فلن ندرس في المؤلفات اللسانية العربية إلا ما هو مرتبط بهذا المستوى ” .
ناقش المؤلف مفكرين ممن يتبنون الاتجاه الوصفي من اللسانيين العرب أصحاب مشاريع أرادوا بها تطوير النحو العربي على أسس لسانية وهما أنيس فريحة وتمام حسان .
تأثُّر أنيس فريحة بالمذهب السلوكي يبدو ظاهرا في رؤيته للغة بقوله :” اللغة تصرف رمزي ولا تفسر إلا على أساس المؤثر ورد الفعل ” ص 227
ويرى بأن اللغة في علم اللسانيات تخضع للتجربة و أن أساس الداء في النحو العربي يعود إلى ثلاث نقاط وهي :
- أن نشأة النحو العربي تأثر بالنحو الأغريقي بواسطة السريان وعلق المؤلف عليه بأن “لا يمكننا أن نتفق معه على أن النحو العربي كان نسخة للنحو السرياني أو الإغريقي أو الهندي لأن القضايا المنطقية المطروحة لا نعثر عليها بشكل واضح في كتاب سيبويه “
- ضخامة التأليف في النحو العربي مما صعب معه الاستيعاب قديما وحديثا
- إن علوم اللغة عند القدماء كانت رياضة فكرية يحتدم فيها الخلاف بين النحاة كل يحتكم إلى الحجة والحجة إما أن تكون عقلية أو لغوية .
ويرى أنيس فريحة بأن تحديد علماء الصرف والنحو لزمن الاحتجاج باللغة أقصى المولّدين واكتفوا بكلام الجاهليين وشعرهم ولم يقع الاتفاق في نظره بين النحاة على مدونة واحدة زمانا ومكانا مما جلب الفوضى في الاحتجاج وحد من خاصية التوليد ومن الارتجال والإبداع في اللغة .
ويعقد أنيس فريحة مقارنة بين النحو العربي وبين علم اللسانيات فبينما النحاة قسموا الكلم إلى ثلاثة أقسام أما لسانيو المدرسة الوصفية فيرون التقسيم أكثر من ثلاثة .
ويرى بأن النحاة اعتبروا الجذر أصلا للكلمة بينما المدرسة الوصفية ترى أن الأفعال جميعا أصول .
ويرى بأن النحو العربي أرجع كل جملة إلى حكم منطقي ، واللغة لا تخضع للمنطق الصارم ، والمدرسة الوصفية تستقري الجمل في اللغة وتُبين الأنماط والأصناف المتنوعة التي تحويها هذه اللغة .
وله أيضا انتقادات تخصّ العلامات الإعرابية والتنوين ذكرها المؤلف وعلق بقوله : ” فكل هذه الأفكار التي دافع عنها أنيس فريحة بحماس والتي استمدها من اللسانيات الوصفية سندها تتحطم على ركائز النظريات الصورية التي أخذت منحى آخر يخالف الوصفيين وأبرزت انتقادات حادة للمدرسة الوصفية ” ص 237
ويقترح فريحة بديلا يعتمد على تقسيم سداسي للكلم وتعريفات ووصف للاسم والفعل والضمائر والصفة والظرف وتركيب الجملة وخلص المؤلف بعد استعراض المخطط العام لمقترحات أنيس فريحة بسؤال : ما الجديد ؟ وأين هي اللسانيات في هذا المخطط ؟
وأجاب في نقاط نذكرها باختصار :
- المؤلف لم يحدد لنا اللغة العربية (المدونة) فعن أي لغة يتحدث .
- هل يكفي أن نقول : هكذا نطقت العرب لنكون لسانيين ؟ وهل العلم يكتفي بالوصف دون التفسير ؟
- أين هي المناهج التجريبية في مقترح فريحة .
وعلق المؤلف على مشروع أنيس فريحة بقوله : “ويبدو لي أن الباحث لم تكن له خطة واضحة في البحث والانتقاد … يرى أنيس فريحة – في نظرنا – أن الجذر هو أصل المشتقات ، وتطبيقا يرى أن الفعل هو أصل المشتقات ” ص 239-240
ثم يستعرض مشروعا آخر لتطوير النحو العربي من الاتجاه الوصفي وهو مشروع اللساني تمام حسان في كتابيه ” مناهج البحث في اللغة ” و ” اللغة بين المعيارية والوصفية ” وهو بحكم ممارسته للمنهج الوصفي في إنجلترا جعلته يرى أنه المنهج الموضوعي المفضل ، وهو جوهر الدراسات اللغوية المعاصرة .
وأهم ما أورده تمام حسان – بحسب رأي المؤلف – في باب المقابلات هو اللغة بين المتكلم والباحث اللساني ، أو بين اللغة كمادة والبحث كنظرية ، فكان يعتقد أن النحو العربي كإطار نظري الذي وصف اللغة العربية ، هو العربية نفسها ، وتغيير النحو العربي يؤدي حتما إلى تغيير اللغة ، بينما هي من الثوابت والمجتمع اللغوي هو الذي يغيرها ، والنحو كإطار نظري هو من المتحولات .
واللغة في تطور دائم ، ودراستها بهذا الشكل المتغير عل مرّ الزمن لا يسمح للباحث وصفها بدقة ، لهذا يجب اختيار مرحلة بعينها وافتراضها مرحلة ثابتة استاتيكية غير ديناميكية فكرة منهجية خالصة فاللغة إذن موضوع من موضوعات الوصف كالتشريح فتمام حسان يرى اللغة عادة من العادات الآلية كعملية التنفس وهذا ما انتقده عليه المؤلف بقوله :” وتشبيه اللغة بالعادات الأخرى يُعدّ في نظرنا مُجانباً للصواب فاللغة ظاهرة سيكولوجية ، والعادات الأخرى – ويقصد مثل عادة التنفس – ظواهر فزيولوجية ، وتمام حسان يستوحي المنهج السلوكي في دراسته للغة .
ويشترط تمام حسان في سبيل تحقيق الملاحظة اختيار شخص بعينه يسمى “مساعد البحث” :
- أن يكون هذا الشخص ممثلا للهجة التي يتكلم بها .
- أن يكون أُمِّياً لا يقرأ ولايكتب .
- أن يكون مُستقراً في مكان خاصّ لم يرحل عن مكان لهجته حتى لا يتأثر باللهجات الأخرى .
وتمام حسان لم يلتزم بهذه الشروط كما ذكر المؤلف في دراسته للماجستير والدكتوراة كما يذكر هو فقد جعل مساعد البحث تارة نفسه وتارة دارس للقانون والمفترض أن يكون مساعد البحث “أمياً” لا يقرأ ولا يكتب.
ويرى تمام حسان أن نقد النحو العربي لابد أن ينصبّ على أسس البناء النظري الذي يقوم عليه وهي : السماع والقياس والتعليل والعامل والمعيارية وتأثر النحو العربي بالمنطق الأرسطي .
ففي السماع ينتقد اعتماد النحاة على مدونة لغوية دامت ثلاثة قرون ، وهي فترة تطورت فيها اللغة تركيبا وصوتيا .
وأيضا لم يعتمد النحاة على لهجة واحدة من لهجات العرب ، ومن الموضوعية في نظر تمام حسان الالتزام بمادة واحدة متجانسة ، ويحسن أن نقتصر مثلا في دراسة اللغة على القرآن والحديث الشريف .
وينتقد تقسيم ابن جني للقياس وهو المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس ويرى أنه لايقبل ويعلق عليه المؤلف : ” أن النحاة العرب استقروا المطرد فوجوده يخضع لقواعد كلية وحينما حاولوا تطبيق هذه القواعد الكلية على بعض الكلمات أو التراكيب في اللغة وجدوها لا تنضبط إلى هذه القاعدة الكلية المسنبطة من المطرد فتطبق القاعدة إذا لم تؤد إلى اللبس ، أما إذا كانت ستؤدي إلى اللبس فلا تطبق .
وأما العامل فيرى تمام حسان أن العلة مرتبطة بالمنطق الأرسطي ، والعامل مرتبط بالعلة وبما أنه يرفض العلة والتعليل ، فلا مراء أنه يرفض العامل ، ويرى أن النحاة العرب مختلفون في العامل ، ويخلص إلى أنه ليس هناك عامل ، وإنما اللغة منظمة من الأجهزة ، ” وكل جهاز منها متكامل مع الأجهزة الأخرى ويتكون من عدد من الطرق التركيبية العرفية المرتبطة بالمعاني اللغوية ”
ويعلق هنا المؤلف بتعليق مهم يوضح خصوصية اللغة العربية والفارق المنهجي المهم الذي أخلّ به تمام حسان وأمثاله من اللسانيين وهو قوله : ” وحين ندرس المستوى النظري في الفكر النحوي العربي يجب ألا نعزله عن المنظومة المعرفية التي نشأ داخلها ” – وفي نظري – أن هذا الملحظ ينطبق على كل لغة بل حتى المنطق الأرسطي لا يمكن فصله عن بيئته التي نشأ فيها وخلفيته الوثنية .
ومما يؤخذ على تمام حسان – كما يرى المؤلف – أنه يتخذ من نحاة ما بعد فترة الاجتهاد – أي ما بعد فترة ابن جني – سندا قويا لنقده ويخلط بين مفهومين للإعراب ، مفهوم نجده عند سيبويه : تغير المجاري لتغير العوامل . ومفهوم ثان نجده في مؤلفات أخرى وهو إبراز الوظائف التركيبية والدلالية ، أو ما أطلق عليه تمام حسان “التحليل” .
وأما المعيارية وهي مرحلة من مراحل الدراسة اللسانية مأخوذة من دوسوسور أطلق عليها النحو المعياري ، ويرى تمام حسان أن النحاة المتأخرين يفكرون في اللغة تفكيرا وصفيا بل رسموا لأنفسهم مجموعة من المعايير يقيسون بها كلام المتكلم ومع اعترافه بأن النحو المعياري لم يظهر إلا بعد انتهاء مرحلة الاجتهاد فإنه يعمم ويصرح بأن النحو العربي نحو معياري .
ويعلق المؤلف :” إن القول : إن النحو العربي كله نحو معياري ، قول يحتاج إلى فضل نظر وتمام حسان نفسه أشار إلى أن سيبويه والجرجاني جردت كتابتهما من المعيارية ، ويمكن القول إن نحو القرون الأربعة الهجرية الأولى كان نحوا وصفيا وفيه كثير من الاجتهاد ” ص 267
ويضع المؤلف سؤالا في معرض نقده لتمام حسان وهو : المنهج الغربي الذي يتحدث عنه تمام حسان هو المنهج الوصفي الذي يتعامل مع مدونة خاصة في اللغة ، إن كانت لغة قديمة ، أو مساعد البحث إن كانت اللغة معاصرة ، فهل استطاع تمام حسان في مؤلفه أن يبقى وفيا لهذا المنهج الغربي ؟
يعترف تمام حسان بأن موضوع بحثه اللغة العربية الفصحى لكنه يستعين في بحثه باللهجات العامية أحيانا لهجة الكرنك ولهجة عدن فلم يقتصر على فصحى النحاة العرب(السماع) ولا فصحى المراحل الزمانية المتأخرة ولا لغة العصر الحديث وفي هذه الحال لم يبق محصورا في قرنين من الزمان وبيئة محدودة في المكان ولم يتحدث عن لهجات العرب القدماء وإنما تحدث عن لهجات المحدثين أضف إلى ذلك اعتبر نفسه مرجعا باعتماده على ذاكرته السمعية في بعض اللهجات فأصبح هو الموضوع والباحث في آن واحد وهذا لايقبل في منهج البحث الوصفي .
***
وفي الفصل الرابع ناقش المؤلف بعض محاولات اللسانيين العرب من الاتجاه التوليدي التحويلي لتطوير النحو العربي .
ورائد الاتجاه التوليدي هو العالم الأمريكي نعوم تشومسكي ويرى أن النحو التوليدي بأنه نسق من القواعد يولد بشكل غير متناه مجموعة من البنيات ، ويتكون النسق من ثلاثة مكونات : المكون التركيبي والمكون الفونولوجي والمكون الدلالي .
وقد تطورت آراء تشومسكي عبر نماذج : النموذج المركبي والنموذج المعيار والنموذج المعيار الموسع ونموذج الربط العاملي .
يقول المؤلف : ” وسأقف فقط عند نموذجي : المعيار ، والربط العاملي ” .
ونموذج المعيار يتكون من ثلاثة مكونات(3) : المكون التركيبي والمكون التحليلي والمكون الدلالي .
وأما نموذج الربط العاملي ” يمكن التمييز بين وجهتي نظر في الدراسة النحوية ، وجهة تفضل أنساق القواعد ، والأخرى تفضل أنساق المباديء ” ص 311
- أنساق القواعد تتكون من ثلاثة أجزاء : أ- المعجم . ب- التركيب : – المكون القاعدي – المكون التحويلي . ج – المكونان التأويليان : – مكون الصورة الفونولوجية – مكون الصورة المنطقية .
- أنساق المباديء التي توزع على الأنساق الفرعية التالية : أ- نظرية سَ ب- النظرية المحورية . ج- نظرية الإعراب . د- نظرية الربط . هـ – نظرية العجر الفاصلة . و- نظرية المراقبة . ك – نظرية العمل .
ويُعدّ الفاسي الفهري رائدا في نقل نظرية النحو التويليدي التحويلي إلى المغرب “ولم يقدم في مؤلفاته نقدا شاملا للنحو العربي ليعطي بديلا بعد ذلك بل حاول أن يتبني نحوا للغة العربية في إطار ما أسماه لسانيات الظواهر متبعا الخطوات التالية :
- إنه يرصد ظاهرة ما في اللغة العربية أو في النحو العربي .
- ينتقد آراء النحاة العرب القدماء .
- يقدم تحليلا لسانيا للظاهرة .” ص 327
ونقد الفاسي منصب على نظرية النحو دون اللغة فهي باعتقاده توجد مستقلة عن النحو الذي يمكن أن يبنى لوصفها أو تفسير ظواهرها مما يسمح للتحليل اللغوي أن يتجدد .
ويوافقه المؤلف من حيث المبدأ لكنه يعلق : ” لابد لمن ينتقد النحو العربي ، ليؤسس على أنقاضه نظرية لسانية جديدة أن يستوفي الشروط التالية :
- الإحاطة الكافية بالنماذج النظرية اللسانية .
- الإحاطة بالأصول النظرية المنطقية والرياضية التي قامت عليها المناهج اللسانية .
- القدرة على اصطناع نماذج من الباحث نفسه مستوفية للشروط النظرية ، ومضاهية للنماذج المنقولة عن الغرب ، لا المحاكاة الآلية للنماذج اللسانية المعاصرة .
- العلم بالنحو العربي والتمرس بأدق آلياته الوصفية والتحليلية والتحقق من أسبابه التاريخية وشروط النظرية .” ص 328
ولاحظ المؤلف على انتقاد الفاسي على النحاة طريقته في انتقاء بعض أوجه الإعراب مثل اختيار الفراء وابن مالك خلافا للجمهور جواز ” اختير الرجالُ زيدا” فقال معلقا :” فكيف نأخذ رأيا ونعممه على النحاة جميعا ؟ والأجدر بالباحث العربي أن يبحث في النحو العربي عما يسانده علميا ، ويقوي عزيمة هذا النحو عوض البحث عن الرأي المخالف لجمهور النحاة لنحكم على هذا النحو بزيف معطياته اللغوية ” ص 331
ويرى الفاسي الفهري أن قول النحاة العرب عن صدارة أسماء الاستفهام وحروفها ، قول غير صحيح في جميع الأحوال وأن الأسماء قد تظل في مكانها داخلة دون أن تتصدرها .
وبعد نقل جواب النحاة عن سبب صدارة أسماء الاستفهام قال المؤلف : ” وخلاصة القول : إن أسماء الاستفهام عند النحاة العرب لها حق الصدارة ، لأنها فرع عن الهمزة ، التي لها حق الصدارة استنادا إلى المعطيات اللغوية ” ص 335
ويرى الفاسي في تحليله للتفكيك يستحسن الافتراض القاعدي عندما لا يترك العنصر المفكك عند نقله أثرا ضميريا ، ويعلق المؤلف :” وأرى أن الافتراض القاعدي هو الذي جعل النحاة العرب يفرقون بين بنيتين أصليتين :
- جملة فعلية – جملة اسمية
وإن كان الفاسي الفهري يرفض وجود بنيتين في اللغة العربية ، في إطار استراتيجية البحث التي يتبناها ، والتي تجعل من اللغة العربية لغة طبيعية من بين مثيلاتها من اللغات الطبيعية الأخرى .
وأما رفضه للافتراض التحويلي فيرجع إلى كون الجمل السابقة … لم يترك فيها العنصر المفكك أثرا ضميريا .
وهذا نقد غير مباشر لنحاة العرب الذين يرون أن الخبر إذا كان جملة لا بد من رابط يربطها بالمبتدأ .. فالنحاة العرب يوحدون بين هذه الجمل بضرورة الرابط مذكورا أو محذوفا ، والفاسي الفهري يوحد بينها بالافتراض التحويلي ، ويرى الفاسي الفهري :” أن بعض النحاة اشترطوا في العنصر المفكك التعريف وهذا غير صحيح ” .
والنحاة في نظري لا يرون ذلك ، إنما يقولون عن “المبتدأ” باصطلاحهم أو “العنصر المفكك” باصطلاح الفاسي الفهري : يكون معرفة أو نكرة مفيدة ، والإفادة عندهم تكون بقيود ” ص 242-239
وبعد نقل اعتراض الفهري الفاسي على النحاة في باب الاشتغال علق المؤلف بقوله : ” وخلاصة القول : أن ليس في بناء النحاة ثغرة وفق قياسهم النحوي الذي وضعوه ، ولا يمكن أن نخطئهم بأدوات خارج تصورهم النظري ، والنحوي لا يتسامح في القياس إلا إذا ورد مسموع يدحض قياسه ” ص 248
والحقيقة أن هذه الخلاصة من الأستاذ الدكتور عبدالله الجهاد تصدق على جميع اعتراضات اللسانيين الوصفيين والتوليديين التحويليين ـ على السواء ـ على النحاة فهم يستعملون أدوات ومناهج أجنبية عن اللغة العربية ويسقطونها على النحو العربي فضلا عن انتقائياتهم لمواضع النقد وتعسفهم في تطبيقاتهم للمناهج اللسانية .
ومما يؤكد ضعف اطلاع الفاسي الفهري لمناهج النحاة العرب ما قاله المؤلف بعد نقله لنص الجرجاني والسيوطي وتحليلاتهم المقنعة في مسألة الربط بين المفسر والعائد قال :” فهذه التحليلات عند النحاة كانت تستهدف اكتشاف وسائل رفع اللبس الذي يقع في الجملة من جراء عود الضمير ، وعدم اطلاع الفاسي الفهري على هذه التحليلات أدى به إلى الحكم على النحو العربي بعدم تقديمه تحليلات مقنعة ” ص 350
وختم مناقشته للفاسي الفهري بقوله : ” تلكم كانت مجموعة من الآراء حاولنا إبداءها ، ولا ندعي فيها العلم والمعرفة ، وإنما استهدفنا من تبيانها إنصاف النحاة العرب القدماء ، وبينا من خلالها آراء النحاة المسكوت عنها ، وقدمنا وجهة نظرنا مقارنين بين ما يقوله النحاة العرب ، وما يقوله الفاسي الفهري ، مبينين أحيانا أوجه التشابه بين تحليل القدماء وبين تحليله للظاهرة اللغوية ، والخلاف قائم فقط في استعمال الوسائل والأدوات ، ولا يمكن لأي واحد أن يدعي أن وسائله هي المثلى … والفاسي الفهري يقول في آخر تحليله لظاهرة البناء لغير الفاعل ” وقد استفدنا في هذا التحليل من بعض آراء النحاة القدامى ، إلا أننا خالفناهم في كثير من المسائل سواء منها التحليلية أو التجريبية “(4) “ص 387.
ومع هذا اللين والحكم المخفف الذي خرج به المؤلف على مشروع الفاسي الفهري والثناء عليه في اعتماده على النحاة العرب في بعض آرائه رجع ونقل رأيه في كتاب آخر بعنوان “البناء الموازي” ف”لم يرجع إلى النحاة العرب القدماء إلا نادرا ، ولم نجد في المواضع شيئا يُذكر عن النحاة العرب ، وعن تحليلاتهم ومناقشتهم ونقدهم كما عودنا في مؤلفاته السابقة ” ص 388
ويخلص المؤلف في الخاتمة : ” ولهذا وقف المعاصرون انطلاقا من تكوينهم اللساني مواقف مختلفة من النحو العربي ، على مستوى النقد ، ولكنهم لم يختلفوا معه كثيرا على مستوى التحليل فتحليلهم ، لسانيين ونحاة ، متشابه في كثير من الأحوال ، بل نجد من المعاصرين من يعيد بناء النحو العربي بهندسة جديدة مستمدا مادته مما كتبه النحاة العرب القدماء ، وتكاد تخلو مؤلفاته من الشواهد العربية القديمة أو الحديثة التي كانت الدليل الأول عند النحاة العرب القدماء ، وكأنه يؤمن أن ما توصل إليه القدماء يغني عن الرجوع إلى المسموع لأنه تحصيل حاصل ” ص 390
وذكر عدة مؤشرات ـ يمكن اعتبارها نتائج للبحث وأهمها ـ الفجوة بين نقد اللسانيين للنحاة العرب بين النظري والتطبيقي وكثيرا مما ينتقده اللسانيون يرجع إلى أصول نحوية قديمة وكأنهم يعيدون انتاج القديم بطريقة جديدة ويُخطيء بعضهم النحاة العرب باعتماده على مقولة واحدة دون البحث في مصادر أخرى .
(4)
مناقشة الأطروحة
وبعد هذه الجولة الطويلة في صفحات هذه الدراسة حول تأسيس النحو العربي وما انتقده بعض اللسانيين من الاتجاه الوصفي والاتجاه التوليدي التحويلي نرجع إلى السؤال الرئيسي وعنوان البحث وهو ما ذكره المؤلف في ص 21 : ” هل للنحو العربي نظرية ؟ وهل له منهج محدد في تعامله مع المادة اللغوية ؟ وما هو الفرق بين نظرية النحاة العرب القدماء ونظرية اللسانيين المعاصرين ؟ وهذا ما نحاول الإجابة عنه ”
وإذا أضفنا إلى ما يشير إليه عنوان الدراسة ” النحو العربي واللسانيات تقاطع أم تواز ” وإلى ماذكره المؤلف في ص 15 : ” فنهضت حركات تحيي النحو العربي تاريخا ونقدا ، لتفتح له باب الحوار مع الاتجاهات اللسانية الغربية المعاصرة في العالم العربي إما مرممة للنحو العربي ، أو معيدة قراءته قراءة جديدة ، أو مطالبة بتغييره ، ووضع بديل تكون اللسانيات المعاصرة سندا قويا لهذا البديل ” .
ونتساءل هنا هل يخرج القاريء بإجابة واضحة عن هذه التساؤلات ؟ أقول باديء ذي بدء : لقد أنصف المؤلف النحو العربي عندما استعرض أسسه وأصوله وأطال في بيانها وأثبت أن للنحو العربي نظرية واضحة الملامح من ناحية حصر المادة اللغوية وتحديد زمن الاحتجاج بها ومن ناحية التركيب والتحليل ولا يضر النحو العربي توسع مادته ولا كثرة الخلافات بين النحاة فهذه زادته ثراءً وخصوبةً في التحليل يضيق بها أصحاب المناهج المخالفة لقلة ممارستهم للنحو العربي ، فالنحو له منهج محدد تختلف فيه المدراس النحوية في التعليل والتحليل بحسب اختلاف اللهجات وما نطقت به العرب فقانون النحاة هو السماع من العرب وما كان عليه جمهورهم ومَن خالف من العرب فهو النادر الذي له وجه ولو كان ضعيفا .
أما جواب المؤلف عن الفرق بين نظرية النحاة العرب القدماء ونظرية اللسانيين المعاصرين ؟ فهذا نستفيده من وصفه للاتجاه الوصفي عند اللسانيين والذي يتعامل مع اللغة وكأنها مادة خام أمامه ينطبق عليها المنهج التجريبي الذي لم يلتزم به أصحابه فضلا عن أن تكون له حقيقة في ميدان اللغة العربية .
وهكذا الحال مع المنهج التداولي التحويلي فهو يلتزم منطق القضايا والمحمولات فيحيل اللغة إلى قوانين رمزية ويريد أن يخطع لها اللغة العربية وأيضا لم يوفق أنصاره إلى تطبيق هذا المنهج على اللغة العربية بكل أمانة وحيادية بل وجدنا منهم الانتقائية في تعميم الخطأ على النحاة العرب اعتمادا على ترجيحهم لقول من الأقوال ولم يتمكنوا من استخراج منظومة نحوية مستقيمة تتفق مع منهجهم .
ويبقى لنا أن نسأل : – ما مدى صحة وجود أصول تلك المناهج في التراث ؟
- وهل اللغة العربية في حاجة إلى تلك المناهج ؟
- ماهدف اللسانيين من نقدهم للنحو العربي ؟ وهل لهم منهجية واضحة محايدة يمكن أن تصنع نظرية متكاملة تجدد للنحو العربي شبابه ؟
- وهل يمكن لمنهج أجنبي عن النحو العربي في نشأته وعقيدته وتصوراته وتذوقه للغة أن يكون له رأيا مع فحول اللغة وأئمتهم ؟
يقول د. مقبل بن علي الدعدي دعوى وجود أصول تلك المناهج في التراث : ” إن سمات المنهج الوصفي وخصائصه … لا تتوافق ومنهج اللغويين القدماء ، فمعيار المادة اللغوية التي تستحق الدراسة مختلف تماما بين المنهجين ، فلا يستحق الدرس والنظر واستنباط القواعد عند القدماء إلا اللغة الفصيحة ، لغة العرب التي لم تشبها شائبة العجمة ، وما نزل على لغتهم من القرآن والسنة ، وأما عند الوصفيين فكل لغة وكل لهجة صالحة للدرس والتحليل ، ومن أجل ألا تختلط ظواهر لغوية بأخرى وضعوا المعيارين الزماني والمكاني ، فتحديد الزمان والمكان ركن من أركان المنهج الوصفي كما أن لغة العرب في زمن الفصاحة الركن الأساسي الذي يقوم عليه منهج اللغويين القدماء ، وإن اتفقوا في ظاهر التحديد الزماني والمكاني فغاية التحديد مختلفة ، والسبب كذلك مختلف … وكذلك الشأن في تحديد المستوى ، فالمقصود عند الوصفيين تحديد لغة الشعر أو لغة الشارع .. إلخ ، وهذا التحديد لم يلتفت إليه اللغويين القدماء ، فالمعيار الفصاحة سواء كان الكلام شعرا أو نثرا “(5) ص 102-103
وأما دعوة تطبيق تلك المناهج الحديثة على اللغة العربية فيقول الدعدي : ” من حيث المبدأ لا إشكال في ذلك بشرط ألا تكسر إجماعا ، أو تخالف معلوما بالضرورة ، ولا تحاول هدم قواعد العربية ، ولا يكون من شأنها مزاحمة تعلم العربية وتعليمها ونشرها … وذلك بعد الاطمئنان إلى انعتاق تلك المناهج عن بيئتها ، وبإمكانية تحويرها لتتوافق وحضارة الأمة الإسلامية والعربية ، ولا يكون ذلك إلا بعد استيعابها ومعرفة منطلقاتها والأسس التي قامت عليها ، والغايات التي ترومها ، والنظر في النقد الذي تعرضت له ، فكثير من النظريات اللغوية سقطت وبان زيفها كنظرية دارون التي بشر بها في اللغة شلايشر ، ونظرية مار الروسي ، بل المنهجان التاريخي والمقارن أصبحا من التاريخ اللغوي “(6) ص 103-104
وقد وجدنا بحسب عرض المؤلف لسلوك اللسانيين العرب من وصفيين وتحويليين كيف يحاولون تطويع القواعد النحوية لمذاهبهم وحرصهم على الانتصار إلى منهاجهم دون اعتبار لما استقر عليه النحاة العرب من
مناهج تحليل وقواعد اللغة بل لا يعتبرونهم مرجعا في اختياراتهم فضلا عن أنهم لم يلتزموا أصلا بتطبيق
معايير مناهجهم فجاءت مشاريعهم مشوهة لا يسقيم حالها مع مصدرها الغربي ولا مع البيئة التي يُراد
تطويرها – زعموا – ويؤخذ على المؤلف – وإن كان انتصر للنحاة العرب القدماء في أكثر من موضع – ولكن لم تكن عبارته جازمة حاسمة مع اللسانيين مع وضوح انحراف منهجيتهم فأنى لهم تطوير النحو أو ترميمه !!
ويلاحظ في هذه الدراسة محاولة الباحث من الاستفادة من مناهج اللسانيين دون المساس بقواعد الأصوليين أو تطويعها لمناهج أجنبية عن بيئتها بعيدة عن منطلقاتها وعقيدتها .
ويمتاز الكتاب بالأسلوب السلس الواضح والترتيب المنطقي لموضوع الدراسات وإحاطته بالأفكار وقدرته على نقد الدراسات اللسانية وتحديد مواضع الضعف والنقص فيها .
(5)
أبرز الخلاصات :
- عظمة النحو العربي وسعة مجالاته وعمق تحليلاته .
- حاجة النحو العربي إلى باحثين لهم مقدرة عالية في استيعاب مناهجه واطلاعهم على الدراسات الحديثة والاستفادة منها دون تحريف لمضمونه .
- الوثوق في الدراسات الغربية والتصميم على سلامة مرجعيتها يوقع الباحث في امتهان للموروث العربي وعدم إعطائه حقه في الدراسة .
(6)
خاتمة
اللغة العربية مجالاتها واسعة من حيث المادة وطبيعة بلاغتها لا تحكمها قوانين رياضية ولا منطقية جامدة بل هي لغة تداولية استعمالية بامتياز تتأثر بالظروف المحيطة بها من تبدل الأعصار والعادات والظروف فتضعف أحيانا وتتراجع فصاحتها ـ عند التداول ـ وترتفع أحيانا أخرى ولا زالت غنية بمفرداتها عميقة في معانيها ودلالاتها وتنوع أسلوبها وحالها مع أصحابها كحال صاحب المال مَن أحسن منهم التصرف فيه وأجاد إدارته في سوقه سعد به واغتنى وإذا أهمله وركن إلى الكسل والدعة كسد سوقه وهذا حال اللغة في زمن علوها وفصاحتها وإبداع كُتّابها وزمن سفولها وركاكتها وركون أصحابها إلى السجع والعبارة المنطقية فالعبرة بتحسين مناهج الدراسة وتقريب اللغة للناشئة والارتقاء بذائقتهم وليس إعمال مبضع جراح أجنبي يعبث باللغة فيخرج مولود خداج أو مخنث لا ينتمي إلى اللغة العربية ولا إلى مناهج اللسانيين .
——————
- :هذه الصورة التي يعرضها المحتل الفرنسي للعالم العربي ليست كل الحقيقة ولاشك في تطور الغرب وتفوقهم التقني لكن هذا لايشمل كل الحياة العلمية كما يُراد لنا أن نصدق ويمكن الرجوع إلى مقدمة كتاب اشتهاء العرب لجوزيف مسعد وكتاب الجبرتي في وصفه للجبرتي الكبير وما كان يدرسه من علوم كمثال لبعض الجوانب العلمية في تلك الفترة .
- أشار المؤلف إلى أن الإحياء والتجديد كانت سمة ذلك العصر وذكر مثالا ” الإحياء في أصول الحكم وكأنه إشارة إلى كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبدالرازق وقد صدر في تلك الفترة وهذا يدعونا للتساؤل عن مفهوم التجديد عند المؤلف هل يشمل الأصول والكليات الشرعية واللغوية بما يتناقض مع المسلمات والضروريات أم هناك ضوابط للتجديد لكي يصح وصفه بالإحياء وليس الإماتة ؟؟
- انظر ص 308 وأضاف في ص 311 مكون رابع وهو المكون الصوتي .
- الفاسي الفهري ، المعجم العربي ص 98
- الاستقبال العربي لعلم اللغة (دراسة نقدية لحركة رواد علم اللغة العرب) الطبعة الأولى 2017 مركز تكوين
- المرجع السابق